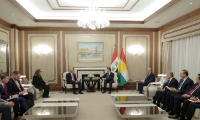عبدالرزاق الربيعي
ذات يوم كنت مدعوا لمناسبة ثقافية في الجزائر، وعندما حان وقت الغداء اندسّ بين المدعوّين شاب أشعث أغبر، ملأ صحنه إلى الآخر، وجلس بالقرب مني، وراح يأكل بشراهة، ولكسر الصمت، سألته إن كان من ضمن المشاركين بالفعالية؟ فأجاب هامسا كلا، فطلبت منه ايضاحا، أجاب» أنا في طريقي إلى أوروبا»، ثم همس بأذني « بوضوح أكثر، أنا مهاجر غير شرعي» قلت له «أليس في ذلك خطورة؟ أجاب» لا توجد مشكلة، فإن وصلت إلى الضفة الأخرى سأعيش بقية حياتي بشكل أفضل، وإن متّ، فسأموت غير مأسوف على حياة لا أجد فيها ما أسدّ به رمقي»، ثم حياني، وغادر المكان قبل أن يفتضح أمره، فتمنيت له حظّا سعيدا!!
ظلّ وجه هذا الشاب الجزائري عالقا في ذاكرتي، واليوم استحضره، وأنا أكتب هذه السطور التي دعاني لكتابتها خبر قرأته عن «هشام» السوري الذي وقف على ضفة البحر في تركيا ليعبر المياه التركية وصولا إلى الجزر اليونانية، في واحدة من حكايات الهاربين من الموت إلى المجهول
بحثا عن ضوء الحرية، والأمن،
والسلام، والطمأنينة، خارج دوائر مناطقنا المعتمة.
كان»هشام» قد تأكد من وجود أهم ثلاثة مقتنيات لديه في حقيبته البلاستيكية، وهي: جواز سفر، وهاتف خلوي، وقلم «لايزر» ليبعث إشارة طلبا للنجدة إن سارت الريح حيث لا تشتهي سفينة جسده، نظر إلى البعيد حيث الجزيرة التي كان متوجهاً إليها هربا من الحرب الدائرة في سوريا، وكان عليه قطع خمسة كيلومترات سباحة متواصلة ليصل إلى تلك النقطة الحلم، كما تروي هانا لوسيندا سميث لصحيفة «التايمز» ، وقبل أن يغرق بعث إشارة بقلم الليزر إلى خفر السواحل الذين نقلوه إلى الشواطئ الأوروبيّة، ولم تنته معاناته عند هذا الحدّ، إذ احتاج لكي يصل إلى ألمانيا حيث يقيم حاليا ثلاثة أعوام ونصف العام قطع خلالها 11 بلدا !!
ويظل «هشام» ابن الرابعة والعشرين عاما الأوفر حظا من الكثيرين الذين لفظت المياه أجسادهم، فيذهب ضحيتها مئات اللاجئين، أطفالا، ونساء، وبين حين وآخر تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن أعداد الغرقى الذين زاد عددهم على 2500 لاجئ، من بين ما يزيد عن 310 آلاف لاجئ سوري عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا، وشكلوا أزمة في الاتحاد الأوروبي الذي فوجئ بأعداد عطايا البحر من المهاجرين، الفارّين من قبضة الموت، ويرى المحللون أن الهجرة الشرعية أصبحت واقعا يفرض نفسه.
يقول الكاتب عبد الباري عطوان « من ينجو بروحه من القصف من هذه الجهة أو تلك، ليس أمامه غير ركوب البحر، أو الشاحنات المبردة بحثا عن ملجأ آمن له ولأطفاله»، وصارت نشرات الأخبار لا تخلو يوميا من أمثال هذه الأخبار، فكلما ضاقت المنطقة بأعين أبنائها بما رحبت، و»استحكمت حلقاتها»، كثر الهاربون من سعير الحروب، والأزمات التي تعصف بها، وارتفعت أعداد الضحايا الذين يلقون حتفهم في البحر، فيصبحون طعاما للأسماك، وقد تتنشل شرطة خفر السواحل الأوروبية جثثهم، أو تلفظهم المياه لترميهم جثثا بلا حراك على الشواطئ التي كان بلوغها منتهى الحلم، كما حصل مع الطفل السوري الذي انتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقميصه الأحمر، وبنطاله القصير، الذي رمته الأمواج على شاطئ يقع قرب مدينة بودروم السياحية في تركيا.
لقد مررنا نحن العراقيين بهذه المحنة، وما زلنا، مع أن الراية تسلّمها المهاجرون السوريون منذ اندلاع القتال في سوريا قبل أربع سنوات، وعلى الدوام هناك
أفارقة، يبحثون عن ضوء في الضفاف الأخرى من البحر، ضفاف توفّر العيش الكريم، وحريّة مناسبة، ولكن من دون ذلك خرط القتاد، واقتحام الأهوال، يقول
الشاعر:
فيا دارها بالحزم إن مزارها
قريب ولكن دون ذلك أهوال
وتبقى تلك» الأهوال» أحنّ على المهاجرين غير الشرعيين من أوطان تنام على أصوات قذائف، وسياط جلّادين، وتصحو على مفخخات، وجوع، وأزمات، وصراعات لا تنتهي، لذا لم يبق سوى ركوب الخطر، و»ما حيلة المضطرّ الّا ركوبها»
والبحث عن حياة آمنة في الضفة الأخرى، إن كتبت النجاة لصاحبها، وإن لم تكتب، فقد انطفأت حياة إنسان غير مأسوف عليها، كما أخبرني المهاجر غير الشرعي
الجزائري قبل أن يودّعني، ويمضي إلى المجهول.
الغرق .. بحثاً عن حياة آمنة

آخر تحديث: