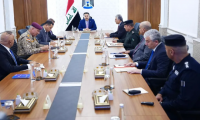د. رسول محمَّد رسول
من هو الإنسان الأخير؟ ببساطة، وبعيداً عن الرؤى الفلسفية ذات التكريس التأملي، الإنسان الأخير هو نحن الذين نعيش الراهن، وتلك ناحية زمانيّة لا ينكُرها أحد من الناس، ولكن لا بد من إضفاء سمة موضوعية تميز هذا الإنسان الأخير، وتلك هي – بحسب رؤيتي – اضطلاع المرء بما هو خفيف في تصريف حياته التواصليّة، فالإنسان الأخير هو إنسان التعامل مع الشيء الخفيف الذي يحمله في حياته اليوميّة، إنه إنسان الخفة (Légèreté)، وحضارته هي حضارة الخفة والخفيف؛ فلعل تداول الانتقال من هاتف أرضي يزن كيلو غرام، مثلاً، إلى هاتف محمول يزن خمسين غراماً أو أقل يعدُّ المثال واضح الدلالة في هذا المجال.
إلى جانب ذلك، يمتاز الإنسان الأخير باختزال (Reduction) المكان لصالح الزمان؛ فقبل قرن من الزمان كنتَ ستحتاج إلى عشرين يوماً، وربما أكثر، لكي تُرسل شيئاً إلى صديقكَ في بلد غير بلدك، أما الآن فإنك لا تحتاج إلى إرسال ورقة أكثر من دقيقة لكي تصل إلى أطراف أخرى عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الضوئيّة، وها هنا اختزال جغرافية المكان لصالح اللحظة الزمانية على نحو مكثف.
ليس بعيداً عن ذلك، يمتاز الإنسان الأخير بأنه موجود رَقَمني (Digitally)، والرَّقْمنة (Digitalization)، وبكُل قطاعاتها، حوَّلت سلوك الإنسان اليومي إلى موجود يصرف الكثير من انشغالاته عبر حواسيب ضوئيّة، خفيفة الوزن، سريعة الاستجابة، مُتقنة الأداء.
إن ما يمتاز به الإنسان الأخير هو الارتماء في أتون ما هو سبراني؛ فهو موجود منخرط في أجواء الثقافة السبرانيّة (Cyber culture)، ما جعله يعيش حياةً سبرانيّة (Cyber life) عندما يتمركز “حول الهاتف الذكي، والآيباد، والحاسُوب المحمول، وأجهزة الإكس بوكس” وغيرها من الكائنات الرَّقَمية خفيفة الوزن سريعة الاستجابة لمطالب الإنسان في حياته اليوميّة.
ولا نغالي إذا ما قلنا مع “ماك برينسكي” إن الإنسان الأخير يحوز شيئاً فشيئاً صفة المواطنة الرَّقَمية (Digital Native)، خصوصاً في ضوء “براعته وألفته التلقائية وهو يتعامل مع التقنيات الرَّقَمية”، سواء في وطنه أو في غيره؛ فبمجرد أن يكون لكً إيميل تتواصل به كونياً مع البشر في كُل أنحاء العالَم، فإنك امتلكتَ ناصية المواطنة العالميّة بوصفك الإنسان العابر تواصلياً من دون حدود جغرافية مانعة.
إن صديقاً لكَ يعيش في باريس تكتب له رسالة إلكترونية وأنتَ تقيم بداركَ في بغداد أو الكوفة، لا تحتاج رسالتكَ هذه إلى جواز سفر حتى تمر إلى بلد المُرسَل إليه؛ بل عبر مواطنتك الرَّقَمية العالمية العابرة لكُل الجغرافيات الممكنة، وهي مواطنه تختزل طريق العبور مثلما تختزل الوثيقة المسافات المكانية المتباعدة في حالة السفر عن مكان ما معين إلى غيره.
عبر – إنسانيّة
من سنة 1936 حتى سنة 1946، وبالتالي في مطلع ستينيات القرن العشرين، ومن ثم في سنة 1993، وعندما بدأ البريد الإلكتروني نشاطه، أخذت الحواسيب تظهر في العالَم كجزء من حياة الناس، وإلى تلك الجهود الاختراعية سينتمي الإنسان الأخير من حيث المرجعية الوسائليّة الجديدة.
في خضم ذلك، وفي منتصف القرن العشرين، كان للعُلماء الذين صنعوا الحواسيب نُظراء لهم يراقبون تلك المُنجزات كمُتغيرات جوهرية في حياة البشر، ولذلك ظهر مُصطلح النزعة عبر إنسانية (Trans humanism)، الذي صاغه، في محاضرةٍ له بواشطن، عالِم البيولوجيا التطوريّة “جوليان هكسلي” في سنة 1951 أكَّد فيه بأن “النوع الإنساني يستطيع أنْ يرتقي بنفسه ليس على نحو فردي إنما بكُل أفراده، أنْ يرتقي بالإنسانية عامة، فنحن بحاجة إلى هذا الاعتقاد الجديد، وربما يصلُح تعبير النزعة عبر الإنسانية في هذا الإطار؛ فالإنسان هو الإنسان، لكنه يعْبر نفسه ويتخطّاها بتحقيق إمكانات جديدة مُنبثقة من طبيعته الإنسانية، ومن أجل طبيعته الإنسانية أيضا”.
تبدو هذه الرؤية منطقية لكونها تدعو إلى تقدُّم البشرية عبر العِلم، وهي رؤية إنسانية تحافظ على مكانة الإنسان في الوجود، فغاية العِلم هي خير الإنسان لا الشر بهم، وهذا ما جرى عندما استفحل استثمار العِلم لصالح قتل البشر كما مارسته بشاعات الدول الاستعمارية والأيديولوجيات الشمولية التدميرية متعدِّدة الاتجاهات في النصف الثاني من القرن العشرين حتى الآن (خصوصا في وبعد 2001)، بحيث تحوَّلت النزعة ما بعد إنسانية أو “عبر – إنسانية” إلى أداة لتدمير البشر على نحو فادح الأثر لتغرق البشرية في أوحال عدميّة جديدة يُدمِّر “الإنسان” نفسه بـ “نفسه” من خلالها بالاستناد إلى فلسفات التفرُّد العرقي أو الدِّيني المذهبي أو المناطقي متطرِّف الرؤية والمُمارسة والغايات.
الغاية والوسيلة
مع ذلك، بقي العِلم يتطوَّر، وصار ممكناً للإنسان أن يحيط وجوده بكمٍّ هائل من وسائل التقنية المتسارعة، لعل أهم مظاهرها التطوُّر الرَّقَمي الذي يندفع بعجالة مدروسة نحو الخفيف لخلق كائنات رقميّة ذكية تتحدّى سرعة الزمن، وتتخطى مكانيّة الانوجاد التقليدي. ولما كان كُل سلوك أو انخرط في سلوك يأخذ المرء إلى نهايات غير متوقعة أحياناً، فإن استغراق الرَقْمنة في دروب الحياة أمسى هدفاً بعد أنْ كان مجرَّد وسيلة، بمعنى – وبحسب ما تقول “سوزان غرينفيلد”، أستاذة عِلمي الأعصاب والنفس التجريبي في جامعة أكسفورد – إن “التكنولوجيا الرَّقَمية أصبحت لديها القدرة على أن تصبح الغاية بدلاً من الوسيلة، أي أنْ تتحوَّل إلى أسلوب حياة في حدِّ ذاتها”. ما يعني ولادة حياة جديدة تبدو حقيقيّة أكثر من مجرّد الحياة المعتادة للإنسان.
على أن هذا لا يُمكن نكرانه؛ ففي ضوء ما يجري، تكاد جُل مُنجزات الإنسان اليومية مُبرمجة وفق ما هو رَقَمي وضمن ثنائيّة ما تُعطي وما تأخذ بينك والآخرين على مدار ساعات متتالية في كُل نهار ومساء، أي أن الرَّقْمنة (Digitalization) أصبحت قدراً لا فكاك عنه بحيث من الصعب التخلي أو الاستغناء عنه، وهذا الاعتياد والتآلف بين المرء وعوالم الرَّقْمنة تركَ وسيترك مؤثراته بالتقادم في طبيعة الذات البشرية وما يحيط بها من العلاقات الإنسانية بكُل حمولاتها العاطفية والنفسية والذاتية والأهوائية، ولعل الأهم هي تلك المؤثرات التي تتوجَّه صوب بنية العقل البشري.