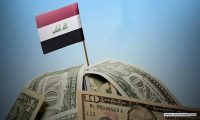بقلم:د. نوري حسين نور الهاشمي
بين الضرائب المرتفعة والأسعار المتصاعدة، يجد المواطن نفسه محاصرًا في حلقة لا نهاية لها من الاستنزاف اليومي.
في العراق، لم يعد الصباح توقيتًا لبداية يوم جديد، بقدر ما صار جرس إنذار اقتصادي يوقظ المواطن على عبء إضافي، وضريبة مستحدثة، وسعر يقفز من دون سابق إنذار. اليوم، لا يسأل العراقي عمّا سيُنجز، بل عمّا سيُقتطع: من راتبه، من سلة غذائه، من دوائه، ومن قدرته على الاحتمال. هكذا تحوّلت الحياة اليومية إلى معادلة خسارة مستمرة، طرفها الثابت هو المواطن، وطرفها المتغيّر سياسات حكومية ترى المجتمع مجرد خزينة للاستنزاف.
ما يشهده العراق اليوم ليس موجة غلاء عابرة، بل نتاج إدارة عامة اعتادت معالجة العجز—وغالبًا العجز المصطنع—بالتحميل المباشر للفئات الأضعف. فالضرائب والرسوم تحت عناوين شتّى—تنظيم، إصلاح، دعم الموازنة—تحوّلت إلى أدوات جباية عمياء، لا تراعي عدالة اجتماعية أو توازنًا اقتصاديًا. وبينما ترتفع أسعار المواد الأساسية من الغذاء إلى الطاقة، يبقى دخل المواطن ثابتًا أو متآكلًا، فتتسع الفجوة بين الراتب وتكاليف المعيشة حتى تصبح غير قابلة للردم.
ضمن هذا السياق، يجد الموظف العراقي، الذي كان يُفترض أن يكون عماد الاستقرار الاجتماعي، نفسه يقيس أيام الشهر بميزان العجز. فالقدرة الشرائية للراتب تتآكل يومًا بعد يوم، لا بفعل التضخم العالمي وحده، بل بسبب سياسات داخلية افتقرت للتخطيط والحماية. راتب كان يكفي أساسيات العيش صار لا يغطي سوى جزء منها، فيما تُرحّل الاحتياجات المؤجلة إلى قائمة لا تنتهي: علاج، تعليم، سكن، ونقل. ومع كل تأجيل، تتراكم الضغوط النفسية والاجتماعية، وتنهك الأسر المحاصرة بين التزامات لا ترحم ودخل لا يرتفع.
أمّا الدواء، فقصته أكثر فداحة. فالحديث عن ارتفاع أسعاره لا يفي بالمشهد حقه؛ نحن أمام أزمة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية. فالأدوية المخصّصة للأمراض المزمنة وكبار السن—الذين لا يملكون ترف البدائل—شهدت زيادات أثقلت كاهلهم. ويزداد المشهد سوءًا حين تتحوّل الصيدليات إلى حلقات جباية غير منظمة، تفرض أسعارًا انتقائية للدواء نفسه، بحيث يتفاوت سعره بين صيدلية وأخرى بما قد يتجاوز ثلاثة أضعاف، في ظل غياب شبه كامل للرقابة الصحية والتسعير الدوائي. في بلد يُفترض أن يضع الرعاية الصحية في صدارة أولوياته، يتحوّل الدواء إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق، لا حق مكفول للمواطن. والنتيجة معروفة ومؤلمة: تقليص الجرعات، تأجيل العلاج، أو التخلي عنه، بما تحمله من كلفة إنسانية وصحية فادحة.
ولا تقف الأزمة عند حدود المعيشة اليومية، بل تتعمّق حين ننظر إلى طبيعة الحكومة. فحكومة تصريف الأعمال، بحكم تعريفها الدستوري، يُفترض أن تلتزم بالحد الأدنى من القرارات وتتجنب السياسات ذات الأثر طويل الأمد. لكن الواقع يكشف العكس تمامًا: قرارات مالية وإجرائية تُتخذ بلا نقاش مجتمعي أو رؤية شاملة، وكأن الزمن السياسي المعلّق يبرّر تعليق الضمير. تتحوّل “التجميعات” والرسوم المتناثرة إلى سياسة ممنهجة، تُراكم على المواطن أعباءً صغيرة في ظاهرها، لكنها كبيرة في مجموعها، حتى تصبح السمة الأبرز للإدارة العامة.
الاضطهاد هنا ليس توصيفًا عاطفيًا، بل وصف دقيق لآلية حكم تُمارس الضغط من الأعلى إلى الأسفل، وتعيد توزيع الخسائر على من لا يملك أدوات الدفاع. بدل معالجة جذور العجز—الفساد، الهدر، سوء التخطيط، تضخّم الجهاز الإداري، وهيمنة الأحزاب على الموارد العامة—يُختصر الحل في جيب المواطن. وبدل تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية بفعالية، تُستنزف الطبقة الوسطى، فتضعف قدرتها على لعب دورها التاريخي كصمّام أمان للاستقرار.
ويزداد المشهد قتامة مع غياب العدالة الضريبية. فالضرائب، في جوهرها، ليست شرًا مطلقًا؛ بل أداة لإعادة توزيع الثروة وتمويل الخدمات العامة وتعزيز التماسك الاجتماعي. غير أنّها، حين تُفرض بلا تدرّج وبلا مراعاة للفروق الطبقية، وتُدار بمنطق المجاملات السياسية، تتحوّل من أداة إصلاح إلى عقاب جماعي. ويتعمّق الخلل حين تُوجَّه نسب كبيرة من العوائد الضريبية—بحسب تصريحات رسمية متداولة—نحو مسارات حزبية ونفقات سياسية، بما يُفرغ الضريبة من وظيفتها العامة، ويحوّلها إلى مورد يخدم شبكات النفوذ أكثر مما يخدم الصالح العام.
في هذا السياق، لا يعود المواطن يرى في الضريبة مساهمة في بناء الدولة، بل اقتطاعًا قسريًا لتمويل منظومة لا تعود عليه بخدمات أو حماية. وفي بلد يتسع فيه الاقتصاد غير المنظّم، يدفع الملتزمون وحدهم الثمن، بينما يفلت كبار المتهرّبين من المساءلة. وهكذا تتآكل الثقة بين المواطن والدولة، وتفقد السياسات المالية مشروعيتها مهما حسنت عناوينها.
الأخطر أنّ هذه السياسات تُنتج آثارًا اجتماعية بعيدة المدى: ارتفاع معدلات الفقر، اتساع الهجرة الداخلية والخارجية، تراجع التعليم، وتآكل رأس المال البشري. وكلها كلف ستدفعها الدولة لاحقًا مضاعفة إن لم تُدار الأزمة بعقلانية اليوم. فاقتصاد بلا مواطن قادر، وصحة بلا دواء ميسور، وإدارة بلا ضمير اجتماعي، وصفة مؤكدة لعدم الاستقرار.ليس المطلوب معجزات، بل إرادة سياسية تُعيد ترتيب الأولويات: حماية الدخل، ضبط الأسعار، دعم الدواء، تطبيق عدالة ضريبية حقيقية، منع تسرب العائدات العامة إلى قنوات حزبية، وإعادة النظر في منظومة الامتيازات والرواتب الخاصة لبعض الفئات. كما أنّ الشفافية في القرار المالي وإشراك الخبراء والمجتمع في النقاش، كفيلة بتخفيف الصدمة وبناء الثقة. فالمواطن لا يرفض المشاركة في تحمل الأعباء حين يثق بأنها موزعة بعدل، وأن ثمنها يعود عليه خدمات وحماية.
في النهاية، لا يمكن لدولة أن تُدار بمنطق الجباية وحده، ولا لمجتمع أن يصمد تحت ضغط متواصل. العراق بحاجة إلى انتقال حقيقي من سياسة “تجميع الخسائر” إلى سياسة “تقاسم المسؤوليات”، ومن إدارة الأزمات إلى بناء الحلول. فالمواطن ليس رقمًا في موازنة، ولا خزينة مفتوحة، بل هو الغاية والوسيلة معًا.واليوم، يصبح من حق—بل من واجب—الشعب أن يقول كلمته حيال تضخّم ثروات الأحزاب والمسؤولين على حساب الجوع والظلم الذي يطال المواطن البسيط. ففي ميزان التقييم العادل، تبدو الحكومات المتعاقبة عاجزة عن إدارة المال العام إدارة رشيدة، جاملت الفساد على حساب المواطن، واستنزفت الموارد في كماليات وامتيازات لرفاهية طبقة ضيقة، بينما تركت الغالبية تواجه مصيرها. أمّا البرلمانات المتعاقبة، فقد تحوّلت—للأسف—إلى واحدة من أكثر المؤسسات استنزافًا للمال العام، دون إصلاح حقيقي أو رقابة فعّالة.وحين يغيب هذا الإدراك، يصبح الصباح—كما هو اليوم—بداية لمعاناة جديدة، لا ليوم يستحق أن يُعاش.