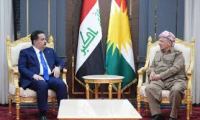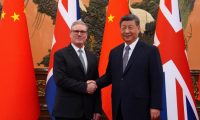لا تزال الدعاية السياسية في العراق، ولاسيّما منذ احتلاله في العام ،2003 تأخذ طابعاً طائفياً في الغالب (سني، شيعي) أو دينياً (مسلم، مسيحي، صابئي، إيزيدي . . إلخ) أو إثنياً (عربي، كردي، تركماني، كلداني، آشوري) وهذه الدعاية تستمر في قصف أدمغة العراقيين شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وتزداد مدفعياتها إطلاقاً ونيرانها كثافة عند اقتراب موسم الانتخابات .
في الإعلام مثلما هو في علم السياسة تحاول الدعاية سواءً كانت بيضاء أو سوداء أو رمادية التأثير في الخصم لإضعافه، وبالتالي لتطويعه أو لجعله يستسلم أو يسلّم بما هو ممكن وموجود، مثلما تحاول بأساليب مشروعة وغير مشروعة، بالاعتماد على الحقائق أو مجانبتها إقناع مَن تدعي تمثيلهم على الانخراط في “موالاتها” لحشدهم وتجييشهم وزجّهم في أتون المعركة ضد الآخر، باعتباره عدواً أو خصماً في إطار شحن طائفي وديني وإثني، وكل ما له علاقة بالولاءات الضيقة التي تدعو إلى الاحتراب والإلغاء والإقصاء والتهميش للآخر، طالما هو من طائفة أخرى أو دين آخر أو قومية أخرى أو غير ذلك .
وإذا أردنا تحليل خطابات السياسيين العراقيين وتصريحاتهم، فإن مضمونها لا يخرج عن تحذير “جمهوره” من الطرف الآخر وإخافته من العدو الداخلي قبل العدو الخارجي، الذي يأخذ مسمّيات مختلفة، ويتم تبشيعه والتشنيع به على نحو شديد، من خلال إشاعة روح الكراهية وأنواع الكيد والعدائية والثأرية ضدّه، فهو تكفيري وإرهابي ومن النظام السابق ومدعوم من دول الخليج وتركيا وجهات دولية أخرى، ومن الطرف الثاني فإن خصمه صفوي وشعوبي ولا وطني ومدعوم من إيران والاحتلال الأمريكي، ولعلّ مثل هذه التوصيفات التناحرية أصبحت معروفة ومتداولة، وكل منها يعني الطائفة الأخرى، في إثارة أجواء الريبة والشك والتآمر والرعب والتوتر والاستقطاب، وفي كل الأحوال ثمة صراع إلغائي، إقصائي، استئصالي أو تهميش في أحسن الأحوال .
الطرفان سواء رغبا أو لم يرغبا يريدان تقوية نفوذهما على حساب الدولة، وكل منهما يريد أن يستقوي على الآخر، ويمارس ما هو مشروع وغير مشروع، بما فيه من أساليب الدعاية السوداء لتشويه صورة خصمه، حتى وإن أدى ذلك إلى إضعاف الدولة وتقسيم المجتمع، وهذا ما هو حاصل بالفعل، فالدولة لم تستطع استعادة هيبتها ونفوذها ووحدانية احتكارها للسلاح واستخدامها للعقاب وفق القانون، خصوصاً ما ظهر من انحيازات وتقاطعات حملت معها مصالح الطائفة أو المجموعة، وجعلتها فوق مصلحة الدولة والمجتمع، الأمر الذي أدى إلى إضعاف فكرة الدولة، خصوصاً أنهما يعتمدان على الانتماءات الضيقة الطائفية والجهوية، ولا يهمّهما إن تفتت الآخر، لأن كل طرف يسعى إلى تماسك طائفته أو الفئة التي ينتمي إليها وتعزيز قوامها تحت قيادته، وبالتالي فرض تسيّدها على الآخر، الذي يميل إلى إضعافه باستمرار، دون إدراك بأن تفتت أية مجموعة، معناه أن جزءًا من الدولة والمجتمع يتم تفتيتهما!
لقد أسهم الاحتلال في تفكيك مؤسسات الدولة على أمل إعادة بنائها وفقاً لمنطلقاته ورغباته وعلى أساس المحاصصة والولاءات الضيقة، وتدريجياً أصبح الجميع رهائن لواقع التقاسم الطائفي والمذهبي والإثني، ولا يستطيعون الخروج من شرنقته، حتى وإن كانوا يحركونه اليوم، علماً بأنه لا يوجد بلد في العالم يستطيع التقدم إذا كان يعاني التفتيت والانقسام المجتمعي الطائفي والإثني، فما بالك عندما يتجه للاحتراب بسبب ذلك، فخلال عشر سنوات ونيّف بدّد العراق مئات المليارات من الدولارات وانشغل بالعنف ودوراته المتكررة والمتواصلة، وهو عنف الجميع ضد الجميع، مهما كانت المبررات .
لعلّ رذيلتين لا تنجبان فضيلة، فالزعم بمقاومة العنف بالعنف، لا يعني سوى استمرار هذه الآفة الفتّاكة التي تمعن في تقطيع أوصال العراق، التي تحتاج إلى معالجات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وقانونية ونفسية، على مستوى الدولة والمجتمع والمدرسة والجامعة والعائلة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الثقافية والدينية والقانونية . وإذا كان العنف المجتمعي لفئات خارجة عن القانون، فلا ينبغي مواجهة العنف باستهداف السكان المدنيين والحرب عليهم تحت مبررات وجود بيئة إرهابية، وإذا كان هناك تطرف وتعصب وغلو لدى هذا الفريق، فلا يمكن مواجهته بالسلاح ذاته، واستخدامات العنف المنفلتة والحرب ضد المدنيين وتدمير الدولة، مثلما لا يمكن محاربة الطائفية بالطائفية، لأن إنتاج مجتمع لا طائفي يقتضي تحريم الطائفية، وعنفان لا يولدان سلاماً، وحسب قول الصديق المفكر اللاعنفي د . وليد صليبي جريمتان لا تصنعان عدالة .
الفضيلة هي بمقاومة العنف باللاعنف، والعمل على اجتثاث العنف بجميع صوره وأشكاله ومبرراته وتجفيف مصادره واقتلاع جذوره بمعالجة أسبابه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والتربوية والتاريخية والنفسية وغيرها .
هل يمكن التصور أن العراق لا يزال على الرغم من الموارد الهائلة من الدول الأولى الفاشلة في العالم حسب تقارير دولية معتمدة، وحتى لو كان فيها ثمة مبالغات، فالعراق لا يزال حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية من أكثر الدول فساداً في العالم وهو في أسفل السلّم، وإنْ تحسّن قليلاً، لكنه لا يزال يندرج في إطار الدول الأكثر فساداً مثل الصومال وليبيا وأفغانستان وسوريا، وغيرها في حين تصنّف الدنمارك من أقل الدول فساداً في العالم، وهي دولة مرفّهة ومستوى حياة السكان عالياً جداً، وإن كانت لا تمتلك موارد طبيعية .
إن الخطاب السياسي العراقي الراهن المنتشر من خلال القنوات الفضائية والإنترنت والفيس بوك والتويتر ينتج يومياً كمّاً هائلاً من أنواع الدعاية والدعاية المضادة ومن المصطلحات ذات المسحة الطائفية التي أصبحت شائعة مثل: المناطق الشيعية أو ذات الأغلبية السنية أو المثلث السني أو المناطق الغربية ذات الأكثرية السنية أو المناطق الكردية أو الحديث عن كردستان باعتبارها أمراً خارجاً عن العراق أو تركمان كركوك وكأنها منطقة تركية أو جنوب العراق الشيعي باعتباره ولاية إيرانية، والهدف هو غياب ما هو مشترك، لاسيّما الطابع العراقي الذي يمثل العراق والمواطنة العراقية، إضافة إلى غياب ما هو عربي، لأن كل عربي حسب وجهة النظر هذه يرتبط اسمه بصدام حسين والدكتاتورية، علمأً بأنه لا يوجد شعب في العالم إلاّ وكان التنوّع والتعددية الديموغرافية والإثنية والدينية والسلالية واللغوية وغيرها، جزءًا من تكوينه سواءً كانت نسبته عالية أو ضئيلة، وعلى مستوى الفرد أو الجماعة .
ولعلّ هذا يذكّر بسؤال غراهام فولر من “مؤسسة راند” المقربة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي طرحه قبل عقد ونيّف من احتلال العراق وكان محوره يدور: هل سيبقى العراق موحداً إلى العام 2002؟ وهو الأمر الذي جاء أوانه بالقضم التدريجي وتقسيم العراق إلى مكوّنات، حتى أصبحت فكرة المواطنة والوطنية العراقية الجامعة والموحدة مسألة بعيدة المنال، لاسيّما في ظل الانقسامات الطائفية والإثنية، وهو الذي استكمله جو بايدن في العام 2007 في مشروعه التقسيمي قبل أن يصبح نائباً للرئيس أوباما .
ولم يكن الأمر مقتصراً على القوى الدولية التي عزفت على مشروع التقسيم، بل إن القوى الإقليمية كان يهمها أن يبقى العراق ضعيفاً وأحياناً يتعاملون معه بالمفرق فيستقبلون زعيم كتلة شيعية وزعيم مجموعة سنية ورئيس برلمان ورئيس إقليم، ورئيس وزراء حكومة اتحادية ورؤساء عشائر سنة ورؤساء عشائر شيعة، وقائمة شيعية وأخرى سنية وثالثة كردية، وهكذا ضاع اسم العراق في ظل ازدحام العناوين الفرعية .
أما الأحزاب العلمانية الوطنية التي تعتمد الوحدة الوطنية مثل الحزب الشيوعي فقد ظلّت غارقة في مشكلاتها وأزماتها وبعيدة عن التأثير في ظل الاصطفافات الطائفية والاستقطابات المذهبية، إضافة إلى شعورها بالذنب والإحراج المستمر جرّاء موقفها من الاحتلال، في حين اندفع حزب البعث إلى الاصطفاف مع بعض الجماعات التكفيرية والطائفية ورفع شعاراتها أحياناً، خصوصاً مع استمرار ملاحقته واجتثاثه، ناهيكم عن كونه مثقلاً بجرائم النظام السابق وآثامه .
الخطاب السائد لا يؤسس إلاّ إلى تكريس البناء الطائفي، وإذا كان ثمة خطوط اعتراضية لأي مشروع وطني عراقي، فهي لا تزال خطوطاً غير واضحة، وفي تقديري إن الخطوة الأولى الضرورية تبدأ من تشريع قانون لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة في العراق، وهو ما جرت مناقشته منذ سنوات من جانب فاعليات فكرية وحقوقية ومدنية عبر ندوات ومعالجات وفاعليات إعلامية، إلاّ أن الخطاب السائد والمتنفذ وقف منه موقفاً ملتبساً، فهو يعلن عن تأييده باستحياء، لكنه في الواقع العملي ومن كلا الفريقين يضعه في الأدراج، لأن ذلك سيؤثر في مراكز نفوذه ويضعف من قدراته على الشحن والتحريض الطائفي، كسلاح فعال بيده حتى الآن .
وإذا بدا هناك نوع من الانحسار النسبي في التأييد للمشاريع الطائفية، فإنها بحكم ما تملكه من مصادر قوة ونفوذ واستمرار الإرهاب والعنف والفساد المالي والإداري، فإن الحلول المطروحة للمعالجة لا تزال ضعيفة وقاصرة أحياناً في ظل القيود الثقيلة التي تكبّل عقول الناس حيث تمطرهم الدعاية الطائفية كل يوم .
رذيلتان لا تنجبان فضيلة … بقلم عبد الحسين شعبان

آخر تحديث: