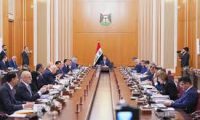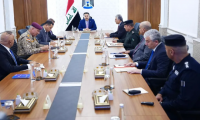آخر تحديث:
بقلم: د. ماجد السامرائي
كانت للطوائف والقبائل والأعراق قبل نشوء الدولة الحديثة جيوشها وأذرعها العسكرية التي تحميها. ولكن منذ بزوغ نجم الدولة في العصر القديم أصبحت لها دساتيرها ونظمها وحكوماتها ومؤسساتها العسكرية والاستخبارية والأمنية. تكونت الإمبراطوريات الكبيرة استنادا على جيوشها الجرارة المرتبطة بها. في الدولة الحديثة، ديمقراطية أو استبدادية، لا يسمح بقيام ميليشيات مسلحة رديفة، لأنها خطر على الدولة قبل المجتمع.
النظم الأيديولوجية في المنطقة هي التي ابتدعت قصة الجيوش والفصائل الشعبية الرديفة لحماية نفسها. حصل هذا في كل من إيران وسوريا والعراق وليبيا، لكن تلك الجيوش المليونية المسلحة لم تتمكن مثلا من حماية النظام في العراق وليبيا وهي لا تحمي النظام السوري لولا الحماية الروسية.
كان يتوقع من الولايات المتحدة حين حكمت العراق بعد عـام 2003، وهي التي قامت على أساس الديمقراطية، ألا تقبل بنشوء ميليشيات مسلحة، صحيح أنها ارتكبت خطأها الفادح بحل الجيش العراقي، لكنها بذلت الملايين لإنشاء جيش صغير موظف للحماية الداخلية شبيه بحماية الشرطة ولا دور له في حماية الحدود، وهي تعلم بأنها غير قادرة على تغيير معادلة العراق وموقعه الاستراتيجي في المنطقة، وسمحت الدولة المحتلة بنشوء الجماعات المسلحة المغلفة بالعقائد المذهبية التي أصبحت تهدّد وجود قواتها نفسها في العراق، مثل “جيش المهدي” بقيادة مقتدى الصدر.
المشكلة التي واجهت العراقيين منذ خمسة عشر عاما ليست في قيام أحزاب طائفية سياسية فحسب، وإنما في امتلاك تلك الأحزاب ميليشيات مسلحة لكي تفرض هيمنتها ونفوذها في الشارع، رغم أن دستور عام 2006 منع وجود سلاح خارج نطاق الدولة، كما منع ممارسة الميليشيات المسلحة لدورها السياسي ومشاركتها في الانتخابات وفق القانون الانتخابي المشرع.
تلك الأحزاب بعضها يحمل أيديولوجيات وبرامج تحاكي بها نظام ولاية الفقيه في إيران، معتقدة أن جيش الدولة الرسمية لا يبيح لعقيدة الانتشار والتوسع عبور الحدود الوطنية، ولهذا فإن قيام “جيش” عقائدي رديف مهم وضروري وفق التجربة الإيرانية التي أثبتت قدرتها على تحقيق هذه الأهداف في كل من لبنان وسوريا والعراق.
هذا ما خلق مشكلة سياسية لم تتمكن القوى وأحزاب العملية السياسية الشريكة لتلك الأحزاب من حلها. حيث أصبحت قوة أي حزب داخل البيت الشيعي الحاكم في العراق مرتبطة بما يمتلكه من أذرع عسكرية. وكانت الفرصة الذهبية أمام تلك الميليشيات هي الحرب على داعش وصدور فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الشيعي الكبير السيستاني. تلك الفتوى التي أطلقت أيدي الشباب العراقي الشيعي للذهاب إلى جبهات القتال ومواجهة المحتل الإرهابي، وتحرير الوطن بصدور أبنائه ودمائهم الزكية. وبذلك قدمت تلك الفتوى خدمة جليلة للجهد العسكري العراقي ومكنته من الانتصار، وكان لا بدّ من أن تنهي أهدافها بإعلان الانتصار العسكري ونهاية داعش في العراق.
لكن هناك جهات عديدة اشتغلت منذ وقت وخلال المعارك على توظيف هذه المسألة للانتقال بها من الوطني إلى المذهبي السياسي بعد أن توفرت لتلك المنظومات العسكرية فرص التوسع والتضخيم وامتلاك أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي تضاهي ما تمتلكه القوات المسلحة العراقية تحت شعارات محاربة داعش وعدم المساس بقدسية الحشد الشعبي لأنه يؤدي دورا وطنيا مشرفا. خصوصا بعد تحويله إلى مؤسسة عسكرية ملحقة بالقائد العام للقوات المسلحة، وهو الإجراء الذي تختفي حوله الكثير من المقاصد السياسية ضمن لعبة الصراع على الحكم بين فرقاء البيت الشيعي.
لكن الزعامات الكبيرة في الميليشيات لم تقبل التلاعب بقضية الحشد ولم تسمح لغيرها بتوظيفه سياسيا، مما حدا بأحد قادته لأن يعلن “إنه حتى لو سمعتم من العبادي إعلانه حل الحشد فلا تصدقوا”، إلى جانب الإعلانات المستمرة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأنه المرجعية السياسية والأب الروحي للحشد الشعبي.
وفي لحظة انتهاء المعارك العسكرية والانتصار على داعش وبدء موسم الانتخابات أخذت بعض قيادات الحشد تشتغل على الدور السياسي لها والتعبئة الإعلامية وسط الجمهور الشيعي، وترفع شعارات عالية النبرة تزاحم من خلالها قيادات الأحزاب التقليدية الساعية للحفاظ على مواقعها والمزايدة عليها بمفردة “القتال ضد داعش”، وانتظمت الاصطفافات داخل البيت الشيعي بخطوط جديدة لم تألفها سابقا، حتى باتت علامات الاستقطاب حادة خصوصا بين المالكي الذي يمتلك إمكانيات تنظيمية هائلة يحاول أن يجعل بعض زعامات الحشد لصالحه، مثل قيس الخزعلي وأبومهدي المهندس إلى جانب هادي العامري رئيس منظمة بدر الذي يشتغل لنفسه في زحام الجولة المقبلة، مقابل كل من مقتدى الصدر الذي يمتلك ميليشيا سرايا السلام والذي خطّ طريقا سياسيا معتدلا ودعا إلى سحب السلاح من فصائل الحشد الشعبي وحصره بيد الدولة وإدماج منتسبيه في القوات المسلحة.
أما رئيس الوزراء حيدر العبادي فيعتقد بأن النصر العسكري على داعش تحت قيادته العسكرية يشكل عنصرا هاما وفاعلا في تأهيله لدورة مقبلة في رئاسة الوزارة، ولكن مسألة الحشد ليست ورقة بيده وإنما بيد خصومه ومنافسيه ولهذا تشكل عثرة أمامه يحاول تجاوزها بحذر شديد، كما أنها أصبحت إحدى نقاط الضغط الأميركي الذي لا يستطيع العبادي تجاهله في مشروعه المقبل، إلى جانب الكثير من الانتقادات المحلية من بعض الزعامات السنية الموجهة إلى ميليشيات معينة داخل الحشد ارتكبت انتهاكات ضد المواطنين من العرب السنة.
ولهذا وجد العبادي نفسه أمام خيار توظيف مسألة رسمية “مؤسسة الحشد” وتبعيتها له، من أجل نزعها من أيدي خصومه، فكانت فرصته الذهبية في دعوة المرجعية الشيعية في خطبة الجمعة، 15 ديسمبر الجاري، التي دعت خلالها إلى حصر السلاح بيد الدولة وإدماج المقاتلين في المؤسسات الأمنية وكذلك في عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في العمل السياسي، ولذلك أعلن في ذات اليوم برنامج حكومته في جمع السلاح وحصره بيد الدولة.
ثم توالت التصريحات من قادة الحشد الشعبي تؤيد أمر السيد السيستاني الواجب تنفيذه “شرعيا”، ويدعو بعضها إلى عدم إشراك الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة، في حين أطلقت تصريحات متناقضة قبل أسبوع من هذا التاريخ يعلن بعضها أن رئاسة الوزراء ستكون في الدورة المقبلة لقائد من الحشد الشعبي، والبعض الآخر تحدث عن قائمة “المجاهدين”، وغير ذلك من الإعلانات الكثيرة التي يبدو منها أن دعوة السيستاني الجديدة قد حسمت الكثير من علامات الاستفهام رغم وجود الكثير من علامات اللبس ما زالت قائمة.
فرغم أن الدستور وقانون الأحزاب لا يجيزان لفصائل الحشد الشعبي الدخول في المعركة الانتخابية إلا أن بعض قياداته كانت لديها مواقع داخل البرلمان، والقسم الآخر أعلن عن كتل انتخابية مثل فالح الفياض الرئيس الرسمي لهيئة الحشد الشعبي، ما جعل المشهد ملتبسا ومحفوفا بالمشاكل وسط توقعات بعدم حصول الانتخابات في موعدها الذي أعلنه العبادي في 12 مايو 2018 بسبب وجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح خارج مدنهم، ويعني ذلك الدخول في الفراغ الدستوري.
جميع الجهات السياسية (الشيعية والسنية) قلقة من موضوع الاختراق السياسي لبعض قيادات الحشد والميليشيات رغم النزع الظاهري لسلاحها، ولهذا جاءت كلمة المرجعية الشيعية مطمئنة إلى حدّ ما لتلك القيادات والجهات في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعني سحب السلاح من قيادات الحشد وتسليمه للحكومة.
ولكن هناك فصائل وميليشيات مسلحة ليست منتظمة بهيئة الحشد ولا تأتمر بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة ولديها خلفيات عقائدية شيعية تابعة لولي الفقيه في إيران ستخلق إحراجات كبيرة أمام العبادي.
والجانب المعقد الآخر والذي يبطن تدبيرات خفية هو أنه تم الفصل بين الحشد والعمل السياسي من جهة، وبين نزع السلاح من فصائله من جهة أخرى، فأين ستصبح قوة قادة التشكيلات والميليشيات، هل ستنزع هذا الثوب العسكري شكليا ومؤقتا إلى حين عبور جسر الانتخابات، وماذا سيحصل لمواقع تلك التشكيلات المسلحة اللوجستية الحاكمة حاليا في كل من الموصل وصلاح الدين والأنبار وجزء من ديالى وكركوك؟ أسئلة تزيد من ضبابية المشهد السياسي في العراق في ظل ما يعيشه أبناؤه من محن.