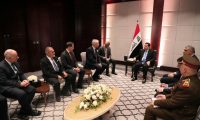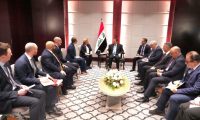علي السوداني
(قليلٌ منا يخرجون من الأزمات الهائلة وفي رؤوسهم متسع لضمائرهم، فمتى إزداد الألم تداعت الفضلية) … فكتور هيجو.
بكل حزن نقول لم يعد موزائيك المجتمع العراقي كما في السابق بأشكاله وتلاوينه، قوميات وطوائف، أديان ومذاهب جميعها كانت مصدر نماء وغنى وإنسجام وسلام مجتمعي.
نعم ، لم يعد، وكل ما يتشدق به سياسيونا اليوم من فوق المنابر والفضائيات ما هو إلا محض هراء وإدعاء وكذب.
بل لم تعد العلاقة داخل الملة الواحدة – بوصفها علاقة مناصرية – قائمة على الشراكة الإنسانية أو العقائدية إلا في الظاهر.
إن ما حصل لعدد غير قليل من الإثنيات العراقية وفي مقدمتها المسيحيين والصابئة والأيزيديين من ممارسات إجرامية يندى لها الجبين الإنساني، تعيدنا الى حقبات تاريخية مظلمة طوتها حركات التطور والتحضر الإنساني منذ عقود زمنية طويلة وأصبحت لوثة في التاريخ الإنساني، وأصبح مصطلح ما يسمى بـ (التطهير العرقي) مصطلحا مقززا يتقدم على جميع الجرائم التي عرفت بـ (جرائم ضد الإنسانية).
لقد أخذ الانتماء للطائفة عند البعض شكلا من أشكال العنصرية، وظاهرة مريبة ومفزعة، حتى بات الفرد العراقي مرتهن – من حيث لا يدري – بهويته الضيقة،
فهو يخشى على نفسه من الأذى وربما الموت، وهو ما دفعه قسرا الى الإحتماء بتلك الهوية العنصرية.
لا أعتقد أن التاريخ سيغفر لنا ممارساتنا اللا أخلاقية هذه ، وما وصلنا إليه لاحقا بعد العام 2006 من درك سحيق قتل فيه العراقي إبن أمته (على الهوية)، لا لذنبٍ إرتكبه سوى إنتمائه لدين أو مذهب أو عقيدة تخالف الآخر، متجاهلين تماما هويتنا الوطنية التي كانت تجمعنا داخل الوطن الواحد، والهوية الإنسانية الموحدة التي تجمعنا من شركائنا من بني البشر في كل بقاع الأرض.
لم تك هناك دعوات صادقة وافعال ناجزة تدعو الى التحاور والصفح والتسامح ، الا في استثناءات قليلة لكنها مع ذلك اثبتت فعاليتها في ايقاف نزيف الدم الى حد معين.
ربما كانت الظروف اللا إنسانية التي مرت على العراق خلال حكم الطاغية والتي أغرقت البلاد بالحروب والحصار والملاحقات والإضطهاد ووتكميم الأفواه وتغييب المعارف والمشاعر الانسانية سببا رئيسيا في إتساع الهوة التي سقطنا بداخلها، لكن ما إستجد في الأمر – في زمن توقعنا فيه إستعادة الحريات الفكرية – هو عدم قدرتنا على تأسيس ثقافة مجتمعية فاعلة كحائط صد جديد يعيد للانسان العراقي انسانيته، وتعرفه بماهية الاختلاف كمظهر وجودي رافق المجتمعات البشرية منذ الأزل، كإختلاف العرق واللون والشكل واللسان، ثقافة تعيد تركيب هذا الاختلاف كعنصر تتوهج منه معاني الاشياء وخواصها وتتولد منه الدلالات .
إن المساعي الجادة لبيان الحقيقة التي يمكن اختزالها بمذهب أو معتقد أو فرد أو جماعة، لم تنل ما تستحقه من إهتمام وأولوية، وأصبح لزاما علينا اليوم أن نبذل أقصى الجهود من أجل توعية الجماهير توعية جادة ومستمرة ليصل الى قناعة من ان الطقوس والشعائر المقدسة قد تكون مظهرا اجتماعيا له ضروراته ، ولكن ، مثلما هي سبيل الى (خير محتمل)، فهي قد تنجرف على أيدي المتطرفين الى (شر محتمل) عند التطبيق، فمساحة التأويل فضفاضة ومطواعة، ومن اليسير التحكم بها بما يرضي أهواء البعض – المنفلت – سواء كان حاكما أو مجموعة أو حتى فرد له سطوته الإجتماعية، ومثلما هي مدعاة للصلاح والاصلاح والخير والسلم المجتمعي،
فهي أيضا قد تنحرف وتصبح وسيلة من وسائل الكراهية والبغضاء والجهل والفساد.
إن للحق مسالك عديدة وآراء قد تتباين لغلبة الظنون على الفكر، أو لسيطرة الوهم على العقل، لذلك وجدنا على الدوام أن العقلاء لا يزعمون القبض على الحقيقة أو امتلاكها، خلافا للسفسطائيين والسطحيين الساعين دوما الى الجزم ومصادرة الرأي الآخر، بل والى تغييبه وقمعه.
لابد من التنويه الى ان الاعتزاز بالانتماء – سواء كان قوميا أو دينيا أو مذهبيا – لا ضير أو إفساد فيه ، إذا ما بني وترسخ على قاعدة احترام الآخر المختلف، لكن الإيغال والتماهي حد العشق النرجسي لعقيدة ما، يتحول الى عنصر هدام وسبب فاعل في إجهاض أي مسعى للسلام المجتمعي.
الأيام تمر وخطورة التعصب والانغلاق على الذات ينموان بإضطراد، ما لم تعاكسهما مساعي مخلصة تحد من تفاقمهما، وما زال أملنا كبير برغم المؤشرات السياسية السلبية في منطقتنا في الوقت الحاضر، والتي يبدو أن لها تأثير بليغ في تسخين المياه السامة في مراجل العقول الموبوءة والضمائر السقيمة.
لم نشهد منذ عام 2003 تغييرات حقيقية أو مساعي ناجزة، فالحال ساء بوتائر أشد، وقد خذلتنا الأكاذيب والترهات والادعاءات، وها نحن نعيش في عراق بائس على مختلف الاصعدة، وهذ ما لا ينكره أحد، لكننا ما زلنا نتشبث بقشة تنجونا من الغرق المحتوم، وما زلنا نهيب بمؤسساتنا المدنية، ونخب المثقفين والمخلصين من أبنائنا، أن تؤسس لإجراءات إحترازية تقينا نشوب نيران حرب طائفية تفتك بنا مجددا، فليس هناك من سلاح يدمر المجتمعات أمضى من سلاح الطائفية.
علينا الإعتراف بأن القوى والأصوات المنادية بالإصلاح ما زالت ضئيلة – للأسف الشديد – إذا ما قورنت بجبهات التطرف والعصبية العقائدية وضجيج الأصوات العالية في فضائيات الفتنة – على اختلاف توجهاتها – التي تعمد الى إثارة الفتن والصراعات والإحتقان الطائفي، ولكن الأمل باقٍ في الضمائر الحية.
فهل بقي لنا من أمل لردع التفكك المجتمعي ؟