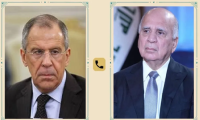لا يخلو مجتمع بشري من الفساد، فذلكم غضب على العباد. وما دام الأمر كذلك، فإن القضية الأساسية فيه تصبح، ليس مجرد حقيقة وجوده، إنما درجة هذا الوجود وتنوع مصادره وإمكانية معالجته في إطار العلاقة المركزية بين أفراد المجتمع وسلطته. ظروف العراق منذ عقود خلت تقدم صورة متكاملة من تطور الفساد، والتي حالياً تنخر عميقاً كالسوسة المدمرة لكيان المجتمع.
الفساد إذن ظاهرة تولدها بيئة المجتمع ولا ريب. مسارات التطور لممارسة الفساد وشموليته تعكس نموذجين أساسيين “لحاضنته”: الفردي والمجتمعي. جوهر الفساد “الفردي” يرتبط بسلوكية بعض أفراد المجتمع في محاولتهم إغواء عاملين في الجهاز الحكومي بغية تحقيق مصالح معينة. في هذه الحالة، فإن “حاضنة” الفساد ومنبعه تكون الفرد المشّخص ذاته، تقابله سلطة تمثل مرجعية الحكم على ماهية هذا السلوك. بعبارة أخرى، فإن إمكانية “ردع” الفساد الضروري تبقى قائمة بالسلطة التي تمثل مصلحة المجتمع واستقرار نزاهة معاملاته، ما دامت تمتلك إرادة الفعل بذلك. وتلك هي الحالة التي سادت في العراق قبل غزوه.
هذه الصورة الفردية للفساد قبل الغزو، تحولت كلياً إلى حالة للفساد “المجتمعي” من بعده. فلقد أضحت السلطة هي الحاضنة للفساد، فأغوت بممارسته كل أفراد المجتمع وبدون استثناء، وبخاصة على الصعد السياسية والإقتصادية. لقد أصبح الفساد فيها شاملاً لكل مرافق السلطة فارتبط بذلك عضوياً مع “فلسفة الحكم” في توافقها مع ممارسات الإضطهاد والطائفية والتهميش التي تعتمدها السلطة. فكان ذلكم الإعلان عن الإنهيار الشامل لأركان منظومة القيم في المجتمع.
إن النتيجة الأخطر من كل ممارسات الفساد المتغير في مصدره وشموليته أنه قد سلب إرادة السلطة في قدرتها على تحجيمه، لأنها أضحت شريكاً أساسياً فيه. وبذلك استحق الحكم القائم وبكل جدارة اللقب الشعبي الدائم: “حاميها حراميها”. فالحكم قد صيّر الفساد هيكلياً وجعله جزءاً في صميم الكيان القابع، فإستحكم بكل المواقع.
إن الفساد الذي تولده السلطة يصبح الأشمل من حيث قاعدة الممارسة، والأخطر من حيث الآثار السلبية في المجتمع، والأصعب من حيث إمكانية التطويق. لقد أقصت ممارسات السلطة الراهنة في العراق كل إمكانات القضاء على الفساد المستشري حالياً إلاّ واحدة وهي: عن طريق التغيير الجذري للنظام الذي يحتويها.