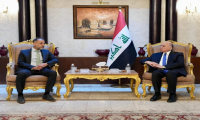لم أشأ أن أتحدّث عن عبد الرحمن النعيمي “أبو أمل” ماضياً، فقد حاولت قدر الإمكان أن أُقاربه حاضراً وربماً مستقبلاً، انطلاقاً من سيرة وسيرورة إتسمت بالتواضع والاعتدال، مثلما انطبعت بالواقعية والدينامية الفكرية النشطة والمتسائلة.
ولعلّها المرّة الرابعة التي أتناول فيها جوانب مختلفة من فكر وممارسة عبد الرحمن النعيمي، ففي المرّة الأولى حين أبعدته الغيبوبة قسرياً عن لقاء رفاقه في البحرين، تناولت عشرة محطات جمعتني مع سعيد سيف “عبد الرحمن النعيمي” على نحو ثلاثة عقود ونصف من الزمان، وفي المرّة الثانية بُعيد وداعه في بيروت يوم تم الاحتفال به في دار الندوة، والتي لمّت المناضلين الذين أحبّوه، والثالثة عند تكريمه في المنامة في ظرف ملتبس وعصيب، لاسيّما عندما احتدمت الأمور. وهذه هي المرّة الرابعة حين تحتضن بيروت مقاسمة مع المقاومة، الاحتفاء بعبد الرحمن النعيمي، أحد كبار رموز الحركة التحررية الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام.
إذا كان لي أن أستذكر حواراتنا المستمرة مع عبد الرحمن النعيمي والتحوّلات التي مررنا بها، ومعنا أخوة وأصدقاء آخرين، فلا يمكن البدء الاّ مما كان يشغله بشكل خاص وأعني، هزيمة 5 حزيران (يونيو) العام 1967 وما شهدته السنوات التي تلتها من قراءات انتقادية للتجربة بما لها وما عليها، ومراجعات فكرية وسياسية لأبرز التيارات السياسية القومية واليسارية، خصوصاً وإن فعل الهزيمة كان حاداً وصارخاً على المستويين الجماعي والفردي على حد سواء.
كانت حواراتنا أيضاً مع بعض قيادات في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشخصيات فلسطينية أخرى، إضافة إلى بعض قيادات يمنية وأخرى عربية، ولم يكن الحوار مع الآخر، سوى حوارمع الذات، وهو الأهم لأنه تواصل ومراجعة ونقد وتصحيح وتصويب. والحوار مع الذات هو حوار مع التاريخ، واستعادة ومراجعة لمنولوجات داخلية ونقدية ووقفات تأملية لفحص الأخطاء الصغرى والكبرى، إنه نوع المحايثة الكثيفة للأنا والأنت وهو جزء من التحقيب المعرفي في إطار تقاطب واختلاف لعقود من الزمان، بين تيارات يجمعها الكثير ويفرقها القليل، لكنها وجدت نفسها في لجّة الصراع متباعدة ومتنافرة لحدّ التناقض.
وعند أول لقاء لنا في عدن، العام 1974وكنت يومها أحضر ندوة عن ” ديمقراطية التعليم والإصلاح الجامعي” عرّفني عليه شايع محسن السفير اليمني لاحقاً في لندن، وقد افتتحنا حديثاً بالحوار عن ثورة ظفار، الذي كان عائداً منها.
وكنت عند كل لقاء لاحق، ولاسيّما بعد العام 1980 عندما وصلت إلى دمشق أشعر أن الحوار الفكري مع عبد الرحمن النعيمي يفرز حالات امتلاء، وهذا الأخير يفضي إلى التحقق، ويقود ذلك إلى الدلالة، وفيها مواصلة وتعبير عن كثافة حضور وتموقع، والامتلاء نقيض الفراغ وهو استحقاق قائم على وعي الذات، أما التحقق فهو شرط الدلالة الوجودية، وهي رهان على الوجود الإنساني.
ولا شكّ إن تطورات مهمة كانت قد طرأت على فكر وهيكليات الحركة القومية العربية، ولاسيّما حركة القوميين العرب، التي انتقلت من المركزية إلى اللامركزية القريبة من الاستقلالية للفروع والتنظيمات العربية، ومن الشعارات القومية الخمسينية: وحدة، تحرر، ثأر، إلى شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية، وكانت صحيفة الحرية اللبنانية، وفيما بعد صحيفة الهدف قد لعبتا دوراً كبيراً في صياغة وعي مرحلة بكاملها، شهدت انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة المقاومة للتعبير عنها.
كان بعضهم يتطور خطوة، خطوة، دون أن يقطع كلياً صلته بالماضي أو يحاول تسويده كلّه، أو يقفز فوق المراحل للانتقال إلى الضفة الأخرى، أو ينتقد خصومه أو المنافسين له من اليسار الكلاسيكي، باعتباره بالياً أو عفى عليه الزمن في إطار توجّه “سوبر يساري”، ولكن مرحلة نهاية الستينيات وبداية السبعينيات شهدت نوعاً آخراً من التطور، فقد أعلنت تنظيمات فلسطينية وعربية غير قليلة عن تبنّيها الماركسية- اللينينية، وإعلان تبرئها من الفكر القومي والبرجوازية الصغيرة، التي أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تحقيق أهداف الأمة العربية في التحرير والوحدة وبناء الإشتراكية.
كان عبد الرحمن النعيمي الأكثر توازناً فيما أحسبه من تطورات طبيعية، فلم تغره تلك التحوّلات السريعة، ومثلما كان النقد للفكر القومي ضرورياً، كان لا بدّ من نقد التيار الماركسي السائد، سواءً في مواقفه من المسألة الفلسطينية، ولاسيّما تأييده اللامبرّر لتقسيم فلسطين ومحاولة أدلجة ذلك أو رفعه شعار إزالة آثار العدوان، ولم يكن من السهولة بمكان إقناع أوساط الأممية الشيوعية بشعار حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني الاّ بعد جهود مضنية، وهو ما كنّا نلمسه في علاقاتنا، إذ كان يغلب عليها الشعار المرحلي التكتيكي “إزالة آثار العدوان”، فضلاً عن الموقف من الوحدة الكيانية العربية، بأشكالها المختلفة، وحتى وإن كانت مسألة عاطفية من جانب بعض القوى التي سرعان ما أثبتت الأحداث عن قطريتها على حساب وحدويتها العروبية، لكن على الماركسيين، وهكذا يُفترض، أن تجد أساساً موضوعياً، إذ أنها تمثّل جوهر ومحتوى التلازم بين القضية الوطنية والقضية الاجتماعية وبين قضية التحرر والعدالة الاجتماعية.
لكن التطوّر الذي حصل لدى بعض أطراف وفروع الحركة القومية بإعلانها عن تبنّي الماركسية- اللينينية، جاء ليلتحق بركب الحركة الشيوعية الكلاسيكية، فما كنّا نعاني منه وتركه بعضنا أو احتج عليه أو تململ بسببه بطرق مختلفة، وجدنا من يتسابق معنا إليه وكأنه اكتشاف جديد.
وفي حوار مع قيادات من قوى مختلفة بحضور عبد الرحمن النعيمي، قال لي أحدهم: هل الماركسية- اللينينية حكراً عليكم ولماذا لا تريدون أن ينافسكم فيها أحد، أهي ملكٌ صرفٌ مسجلٌ بالطابو للأحزاب الشيوعية؟!، وذلك ردّاً على سؤالي: لماذا تتسابقون بالإعلان عن تبنّيكم للماركسية – اللينينية كما كانت متداولة، وأقصد بالصيغة التي وصلت إلينا، وهي صيغة كانت قد فقدت صلاحياتها؟ أليس من الأفضل وأنتم في مرحلة تحرر وطني أن تبقى منظماتكم تتسع لتيارات عريضة، وربما كانت مثل هذه الأطروحة أقرب إلى ” فتح” منها إلى تنظيمات يسارية فلسطينية.
قلت له جواباً على جوابه: خذوا الماركسية – اللينينية هديّة منّي إليكم، فنحن لم نفلح أن نترجمها على أرض الواقع، ولذلك فشلنا في مواقع غير قليلة، وإذا أردنا أن نعدّد نجاحاتنا، فهي تتعلق بنشر الثقافة الماركسية، حتى وإن كان الأمر بطبعتها غير الصالحة للاستعمال، لكن معها كانت قيم العدالة والمساواة والتآخي بين الشعوب وعدم التمييز والاستغلال ورفض الظلم الطبقي والاجتماعي والدعوة إلى حقوق المرأة وحقوق المجاميع الثقافية، وهو ما يصطلح على تسميته بحقوق الأقليات، على الرغم من أنني أفضل “حقوق المجموعات الثقافية: القومية والدينية واللغوية والسلالية وغيرها”، وتلك مثّلت الحاجة إلى المدنية والحداثة والتقدم الاجتماعي والعقلانية والحريات.
ولكنني لا أخفي عليك كما أردفت: نحن أيضاً تأثرنا بلغة المقاومة الفلسطينية، ومفرداتها بعد العام 1967، وحريتها في النقد، لاسيّما لبعض يقينياتنا ذات الصفة التبشيرية والتعبوية غير العقلانية، وهو الأمر الذي حصل للجميع على ما أظن، فإضافة إلى الموجة العالمية الانتقادية للتطبيقات البيروقراطية الاشتراكية وفروعها فيما أطلقنا عليه بلدان حركة التحرر الوطني بقيادة الديمقراطيين الثوريين، الذين يمكن أن يمضوا بتجربة التطور اللارأسمالي صوب الاشتراكية، كانت المراجعات تتسع لجوانب الفكر والثقافة والأدب وأشكال التنظيم والإعلام وغير ذلك.
وكان مثل هذه الإنتقادات قد لقيت أذاناً صاغية بسبب الحركية الجيفارية وتجسيداتها البطولية وتيارات اليسار الجديد في أوروبا وما بعد مدرسة فرانكفورت والمساهمات الجديدة في حقول الميثولوجيا والانتربولوجيا والنقد الأدبي والجماليات وعلم النفس، ولا شكّ أن السارترية والبنيوية وجاك ديردا وميشيل فوكو وألتوسير من ساهم في وضع أساسات ظلّت راسخة إلى حدود معينة في نقد التركيب الاشتراكي الكلاسيكي لمقوّمات الفكر السائد والعقل السائد.
وقد لعبت مجلة الكاتب المصرية والطليعة المصرية واليسار اللبناني بشكل عام بما فيه الشيوعي ومجلة الحرية والهدف فيما بعد دوراً كبيراً في ذلك، في نشر حوارات متنوّعة، لاسيّما بعد الثورة الطلابية في فرنسا (أيار/مايو) العام 1968.
لم يكن عبد الرحمن النعيمي ليهدأ أو ينام، فداخل منظومته وأحلامه ورؤاه الفكرية كانت تجري تحوّلات ديناميكية، وأصل الفلسفة كما قيل حوار وجدل، ولذلك كان يميل إليهما، لأنه يجد فيهما بحثاً وتوليداً، ونوعاً من السباحة نزولاً إلى الأعماق أحياناً، وصعوداً فوق التيارات أحياناً أخرى.
لم يكتفِ النعيمي بنقده الذاتي للتوجهات السائدة في الحركة القومية العربية، ولم يكن أيضاً يقبل بالمقولات الجامدة التي درج عليها التيار الماركسي السائد، ولذلك وجد نفسه باستمرار يسعى للبحث والتنقيب، بل والحفر أحياناً بأرض بكر عن مزاوجات طبيعية بين العروبة في إطار يساري، اجتماعي، وهو ما كان قد بدأه نخبة من المفكرين العروبيين من ذوي التوجه اليساري والماركسي.
لقد ظل النعيمي على الرغم من انتقاله إلى مواقع اليسار العقلاني متمسكاً بعدد من الثوابت، لم يحد عنها في منطلقاته الفكرية التي أجرى عليها التعديلات الضرورية ومنها: اعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية، مهما ارتفعت الأصوات: هذا البلد أولاً أو ذاك، فقد ظل في كل جزئياته ” فلسطينياً” حتى النخاع وعروبياً حقيقياً في العمق والأداء، وإنْ اعتز بخليجيته وبحرينيته، لكنه لم يكن يشعر بالتكامل الاّ ببعده العروبي والإنساني أيضاً.
وعندما اشتعلت الحرب بين العراق وإيران 1980-1988، كان من المبادرين إلى رفع شعار وقف الحرب فوراً والجلوس إلى طاولة المفاوضات، واعتبر تلك الحرب لا تخدم سوى الامبريالية والصهيونية، وبعد غزو القوات العراقية للكويت في العام 1990 أدان تلك المغامرة، ولكن حينما تجمّعت قوات التحالف الدولي لشن الحرب على العراق، وقف ضد الحرب أيضاً، ولم يهمّه إن كان موجوداً في بلد شارك حينها، في قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت، فاعتقل في سوريا وبقي فيها لحين انتهاء الحرب وتحرير الكويت، ولكنه لم يغيّر موقفه، وإنْ ظلّ ضد سياسات بغداد القمعية، لكنه كان ضد الحصار الدولي الجائر ودفع الثمن باهظاً، وعندما وقع العراق تحت الاحتلال، كان موقفه إدانة الاحتلال، الأمر الذي دفع بعض القوى للإفتراء عليه، والسعي إلى تشويه موقفه الوطني والعروبي الحقيقي والمتوازن والمبدئي.
لم تكن الوسيلة الشريفة لدى عبد الرحمن النعيمي تختلف عن الغاية الشريفة التي آمن بها، وإذا كنّا لا نستطيع التحكّم بالغايات، أي بالوصول إليها، لكن يُمكننا التحكّم بالوسائل وخياراتها، ولعلّ ذلك ما كان سيعني التحكّم بالغايات أيضاً من خلال اختيار الوسائل.
وإذا كانت الغايات مجرّدة، فالوسائل ملموسة، والأولى تعنى بالمستقبل، أما الثانية فتعنى بالحاضر، الوسيلة هي شرف الغاية، لاسيّما إذا كانت الأهداف متشابهة أحياناً، لكن الفوارق الجوهرية هي في الوسائل، والوسيلة لدى عبد الرحمن النعيمي هي المقياس للغايات والأهداف والأفكار، وتلك مسألة جوهرية وليست عابرة، لأن الوسيلة تتوحد بالغاية، مثلما لا انفصال بين الجلد والجسد.
كان معيار عبد الرحمن النعيمي أخلاقياً، والسياسة لديه ستبدو بشعة وكريهة دون الأخلاق، وبقدر اقترابها من الأخلاق ستكون مؤثرة وفاعلة، ولعلّ أي انتصار حقيقي هو في تحقيق الغايات النبيلة والشريفة، ولكن بوسائل شريفة أيضاً.
وبقدر علمانية ومدنية عبد الرحمن النعيمي لم يكن يهمل الظاهرة الدينية وهو من أوائل المثقفين السياسيين اليساريين العروبيين الذين بحثوا في هذه الظاهرة، مثلما أقاموا علاقات مع قوى وتيارات إسلامية أو متأثرة بالإسلام، وقاده ذلك إلى التحالف لاحقاً مع التيار الإسلامي في البحرين في إطار عمل مشترك وتعاون وتنسيق في الانتخابات البرلمانية، كما بذل محاولات طيلة عقدين من الزمان للتقارب مع الجناح الآخر في التيار اليساري “جهة التحرير” سواءً قبل العودة إلى البحرين أو بعدها، عندما تم تشكيل جمعية الأمل وجمعية المنبر الديمقراطي، وكان يعتقد أن جبهة اليسار هي الأولى وحجر الزاوية في جبهة التحالف الوطنية والتقارب مع الإسلاميين الذي كان يدعو له.
وكنت قد توقفت عند موقفه المعتدل والوسطي منذ عقود من الزمان، ولاسيما خلال ندوة للحوار بين التيارين القومي والماركسي، انعقدت في طرابلس (ليبيا) في العام 1984 على ما أتذكر، وحضرها نخبة من القياديين، وجرت فيها مناقشات عميقة حينها حول “الأزمة في حركة التحرر الوطني العربية”، وكم كان مهموماً بتيار عروبي يساري يشكل نواة حقيقية لمراجعة الأزمة البنيوية، ويراجع مسارات الحركة التحررية العربية، لاسيّما التوقف عند التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بهدف التغلّب على الصعوبات والعراقيل التي تعيق انطلاقتها، وخصوصاً ضعف التوجه الديمقراطي لدى فصائلها وأحزابها.
كان عبد الرحمن النعيمي حالماً، بقدر ما كان واقعياً أيضاً وعملياً في الوقت نفسه، واستحق تقدير واعتراف الجميع من ممثلي الأحزاب والقوى العربية، فقد كان قادراً على تغليب ما هو عام على ما هو خاص، باحثاُ عن المشترك الإنساني واضعاًً قضية التحرر بتلازمها الوطني والاجتماعي، العروبي والإنساني في إطار هارموني.
والأهم من كل ذلك كان إنساناً يتدفق محبة وإخلاصاً في علاقاته الشخصية والعامة فحظي باحترام لا حدود له في الاتفاق والاختلاف، ولم يدع تلك الاختلافات تكون عائقاً أمام استمرار علاقاته الإنسانية. لم يكن تطور النعيمي سوى تراكمات موضوعية وذاتية وقراءات ومراجعات وتجارب فيها الناجح والمؤثر وفيها الفاشل والسلبي، ولكنه كان يختزن عبراً ودروساً باعتبار النظرية ليست مجردة أو رمادية، لأن شجرة الواقع كانت تغذيها باستمرار وهذا ما آمن به النعيمي كيساري أصيل.
كلمة قدمت يوم 15/12/2013 في منتدى عبدالرحمن النعيمي (بيروت) في ذكرى غيابه والتي شارك فيها نخبة من الشخصيات الفكرية والسياسية والثقافية العربية.