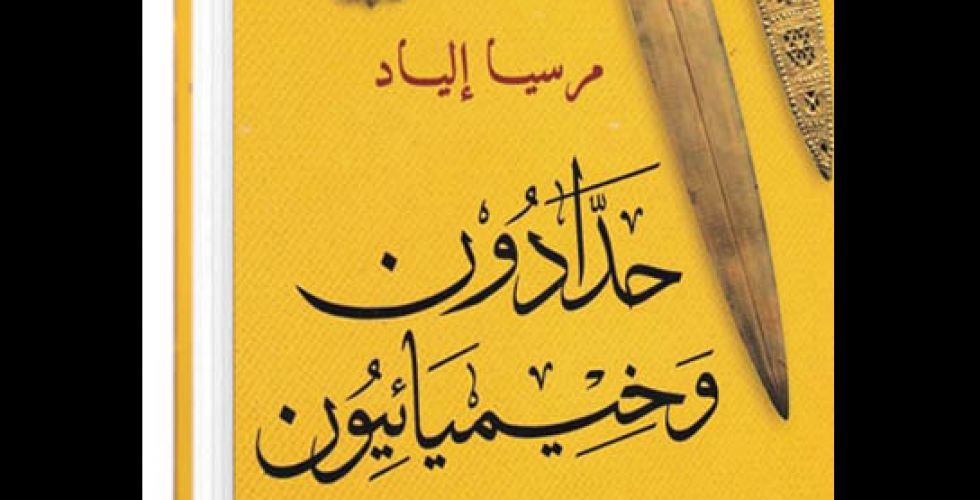آخر تحديث:
د. رسول محمد رسول
في مثل هذا الشهر كان المؤرخ والفيلسوف في تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية والأساطير الروماني الأصل “مرسيا إلياد” قد توفي، وكانت وفاته جرت في الثاني والعشرين منه سنة 1986، بعد أن ولد في بوخارست سنة 1907. وفي سنة 1956 نشر كتابه (حدّادون وخيميائيون ) = (Forgerons et Alchimistes)، لكنّ المترجم الدكتور محمد مهدي ناصر الدين اختار طبعة سنة 1977 من الكتاب ذاته، وهي طبعة مهذّبة ومزيدة ليزفها بلغة الضاد إلى القرّاء العرب بعد أن قرؤوا مؤلّفات أخرى للمؤلف نفسه.
وميزة هذا الكتاب أنه يضم كتابات مرسيا إلياد الأولى في حياته تلك التي حرص على نشرها للقرّاء، وهو الكتاب الذي قدّم له “ستانيسلاس دوبريه”، الأستاذ بـ (الجامعة الكاثوليكية) في مدينة ليل/ فرنسا، بتقدمة شمولية لما أقبل عليه إلياد في هذا الكتاب وغيره من كتبه لتضعنا عند أطراف مشروعه فيما كتب، وتبرز عناوين ضمن تقديمه، ومنها: بورتريه لمرسيا إلياد في الخيمياء، ومؤرخ أديان أو فينومينولوجي، وفي البحث عن الإنسان الديني، وعالم مقدّس وعالم مدنس، وروحانية في عمل المادّة، والجانب المظلم للخيمياء.
خيمياء وكيمياء
في مقدمة المؤلف الروماني يأخذنا المؤلف إلى عالم الصانع والحداد والخيميائي لكون هؤلاء المَهرة “يتبنّون تجربة سحرية دينية في علاقاتهم مع المادّة”؛ فهؤلاء الثلاثة يشتغلون على “مادّة يعدونها حية وقدسية” وفق سلوكات خاصّة بهم وبالمادّة يطلق عليه إلياد “تدخل الإنسان في الإيقاع الزمني الخاص بالمواد المعدنية الحية”، وهنا تكمن “نقطة الالتقاء” الخاصّة بهؤلاء الثلاثة، ولكن ما الفرق بين الكيمياء والخيمياء؟ يستشكل إلياد الأمر، لكنه يجتهد ليقول: “ولدت الكيمياء من الخيمياء، وبشكل أكثر دقّة ولدت الكيمياء من تفكّك التصوّر الخيميائي”، والإشكال هو أن عدم اعتراف “تاريخ العلم بقطيعة حادّة بين الخيمياء والكيمياء”، وكانت الأولى أو الخيمياء “طرحت نفسها كعلم قدسي” بينما الثانية لم تفعل ذلك، وهنا مكمن الفجوة بينهما! ويزف لنا مقارنة رائقة في هذا الإطار ليقول: “يمارس الكيميائي الملاحظة الدقيقة للظواهر الفيزيائية الكيميائية من أجل اختراق بنية المادّة بينما يتعلّق الخيميائي بمعاناة المادّة وموتها وزواج المواد الذي يتعلّق بالنظام اللازم لتحول المادّة أو الحجر الفلسفي والحياة الإنسانية أو أكسير الخلود”. ويقول أيضاً: “تمثل الكيمياء سقطة، على الأقل، لكونها تمثّل علمنة لعِلم قدسي”. ويصِّر مرسيا إلياد على أننا في خطأ عندما نعتقد بأن “الخيمياء مرحلة تمهيديّة للكيمياء” أو كونها “علماً مدنساً”، فهو إنما يريد إبقاء الخيمياء في تقديس من أمرها.
خزّافون
يعتقد إلياد بأن “الشهب هي جزء من القدسية السماوية”، ويقدّم أدلة من القدماء الذين كانوا يبجِّلون هذه الفكرة لكون الشهب تسقط من الأعلى نحو الأرض، ومن هنا ولدت فكرة بأن تكون الشُهب “صورة مباشرة للألوهية”، وهنا انتقال للقدسية يحتفي به المؤلِّف عندما يذهب إلى سومر فيقول: إن اللفظ إن (An) بار (Bar) هما الأقدم للحديد المكوّن من رموز “صورية هي السماء والنار”، أو “الفلز السماوي”، والحديد، سواء سقط من القبة السماوية أو تم استخراجه من أغوار الأرض فهو “مشحون بطاقةٍ قدسيّة”، وهو أيضاً “يحتفظ بامتيازاته السحرية الدينية لمذهلة”، وتحت عنوان “العالم مجنسناً” يذهب المؤلِّف إلى “تطعيم النخيل والتين في بلاد الرافدين”، ونعثر في شريعة حمورابي أصول ذلك ما يدل على “الجنسانية والخصوبة والموت والبعث”، ويتذكّر ما ورد عن بلاد الرافدين في كتاب ابن وحشية (الفلاحة النبطية)، والرائق في رأيه عندما يقول: “إنه تمّت جنسنة الأحجار والأحجار الكريمة بشكل مواز عندما قسّمها سكان وادي الرافدين إلى مذكرة ومؤنثة بحسب أشكالها وألوانها ولمعانها”، وكان العرب يسمون “الحديد الصلب ذكراً والحديد الرخو أنثى”.
ويتوغّل مُستعرضاً “أساطير الإنسان المتولّد من الحجارة والمعتقدات حول تناسل ونضج الحجارة والمعادن في أحشاء الأرض”، ولذلك يستخدم مصطلح “الأرض الأم”، ومن ثم يتعرّض بالأدلة التاريخية على ذلك. وتحت عنوان “شعائر وأسرار فلازية” يشير المؤلِّف، وعبر مأثورات، إلى أن “مكتشف حِرف التعدين والفلازة بمثابة نصف إله أو بطل حضري أو رسول للرب”.
هل توجد خيمياء بابلية؟ سؤال بحث طياته المؤلِّف؛ ففي بابل تم اكتشاف “مستند تاريخي يخص فكرة انضاج وتطوير المعادن” ويعده “الأصل التأسيسي الرافديني للخيمياء”، ويورد المؤلف نص ما جاء من بابل تبدو القدسية الطقسية فيه واضحة مثل: اختيار أيّام عمل الفرن، والأضحية المرافقة، والطهارة، والقربان، والمبخرة، وكل ذلك في جوٍّ تمهيدي لعمل الفرن، وهو طابع شعائري في العمل الفلازي بوادي الرافدين، وكم كان الاحتفاء بهذا الطابع قائماً، وها هنا اشتغال للرحم أو “الفرن – الرحم” ضمن طقوس وشعائر قدسية لأننا بصدد ولادة لأشياء يتم إنتاجها في الفرن، وما يريد قوله المؤلِّف هو أن الإنسان له القيمة عندما يتدخّل في ولادة الأشياء الفلزية والحديدية لخلق عوالم جديدة واضحة التكوين والإنشاء منها.
النار
وهل تغيب “النار” عن كل ذلك؟ بالطبع كلا؛ فالنار هي المحور سواء في الفرن أو الولادة، ولذلك يقول إلياد: إن “الخيميائي كما الحدّاد، وقبله الخزّاف، هو سيد النار؛ فالخيميائي يعمل بواسطة النار على تحويل المادّة من حال إلى حال، ولذلك عرف الخزّاف نشوة الخالق؛ فهو أول من نجح بواسطة الجمر في تصليب الأشكال”، لقد كانت النار “مظهراً لقوة سحريّة – دينية بمقدورها تغيير العالم”.
ويأخذنا المؤلف في سياحة مع عادات وتقاليد عديدة بالعالم القديم – الحديث كان الحدادون ربانيين وأبطالا حضريين في الهند وإندونيسيا ومناطق بالغرب الحديث والأفارقة، ويأتي على ذكر “الحداد السماوي” الابن للإله الأعلى الذي يعمل بهديٍ منه، وعلى نحو رائق يذهب بنا إلى أساطير مختلفة لبيان الصراع بين “الرب السماوي” و”التنين البحري” تحت عنوان “حدّادون ومحاربون وأساتذة”، ومن ثم يذهب بنا إلى “الخيمياء الصينية”؛ فالصين برأيه “لم تشهد فراغاً بين الروحانية والفلازية والخيمياء”، ولا يختلف الأمر مع “الخيمياء الهندية”، ويعترف المؤلف بأن “الخيمياء الإسكندرية والعربية موضوعها ضخم للغاية”، لكنه يحيلنا على دراسات ومصادر واسعة العدد، وهذا دليل ضخامتها؛ إذ أن “كتب الفلازة وصناعة الفضّة في الشرق القديم تؤكّد” على هذه الضخامة، وينوّه بصريح القول إن “الشرق الهليني استعار كل تقنياته الفلازية من بلاد الرافدين ومصر”، وهذا مؤشر واضح يُحسب لمرسيا إلياد تجاه المنجز الفلازي في العراق ومصر؛ إذ وابتداءً من القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت “شعوب الرافدين قد وضعت الأساس التجريبي للتعامل مع الذهب”، ومن ثم يعرج المؤلّف على “فن الأسرار” في هذا الشأن، ثم “الخيمياء والعلوم الطبيعية الزمنية”، ويختم كتابه الجميل هذا بحواشٍ وإحالات تفصيلية عن الشُهب، وحجارة البرق، وبدايات الفلازة، وأسطوريات الحديد، وعلم أصل نشوء الكون، وتخصيب النبات والممارسات التهتكية، والرمزية الجنسية للنار، والرمزية الجنسية للمثلّث وصخرة والولادة، والخيمياء في الأدب الإنجليزي، والخيمياء البابلية، والخيمياء الصينية، والتقاليد الصينية، والفلكلور الخيميائي، والخيمياء الهندية، وملح الأمونيا في الخيمياء الشرقية، والتاريخ العام للخيمياء المصرية – الإغريقية والعربية الغربية، ويونغ والخيمياء، والخيمياء في عصر النهضة، وفي عصر الإصلاح، وأخيراً قائمة الفلازة والتعدين، وكل ذلك يأتي في معرض تخصيص معلوماتي هائل الفائدة للقارئ والمتخصّص وللتاريخ.وبعد، فإن ترجمة هذا الكتاب تعد مؤشرا على عظمة الجهد الذي بذله مرسيا إلياد في كتابه هذا، ولعل الأهم هو ما جاء به المترجم الدكتور محمد ناصر الدين في نقله لهذا المتن من لغته الأم إلى لغة الضاد بحيث تبدو صياغة العبارة تتماثل مع أسلوب المؤلّف الروماني في كتاباته، ورشاقة الطرح والمعالجة ودفق المعلومات التاريخية التي يزفها للقارئ المهتم بما يكتبه في شؤون ما تعرّفنا إليه في هذا الكتاب الذي تأخرت ترجمته، مع الأسف، لسنوات طوال، حتى تنبّهت إليه “دار الرافدين” في بيروت وبغداد لتقدّمه إلى المكتبة العربية بترجمة متأنية حريصة على الأمانة العلمية مستوفية لشروطها.