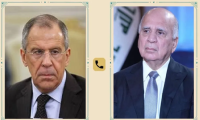شبكة أخبار العراق / قدمت في الحلقات السابقة عرضاً موجزاً لواقع مشروع الإسلام السياسي، وبينت فيه رأيي بان الإسلام السياسي اليوم هو نتيجة قناعة قادة هذا المشروع بأنه يستمد مشروعيته من الإرث الإسلامي الذي أثبت منذ القرن الأول الهجري أن الغزو وما يترتب عليه من قتل وخراب وإغتصاب ليس فقط مسوغاً بل هو واجب من أجل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله في الأرض. وقد استمد قادة المشروع الإسلامي المعاصر ومن خلفهم من المنظرين والمفتين ذلك من سياسات خلفاء المسلمين في حكم الأمويين والعباسين والعثمانيين.
كما بينت رأيي المبني على آيات الكتاب المبين أن الإسلام لم يأت بأمر الغزو أو القتل، كما انه دين العرب أو من إستعرب. فإذا كان كذلك فليس هناك دعوة تلزم أي مسلم بنشر الدين، كما زعم عدد من المسلمين الأوائل.
ولست أطمح في ما أكتبه إعادة لكتابة التأريخ حيث إن التأريخ لا تعاد كتابته لأنه في الأغلب ليس ما حدث فعلاً ولكن ما يعتقد الناس أنه حدث، أي انه قناعات وليس بالضرورة حقيقة وهذا لا يعني أن كل تلك القناعات مغلوطة ولكنه قد يعني في الوقت ذاته أن بعضاً منها مغلوط وهو من صنع الخيال أو الآمال! إلا ان ما أكتبه هو بهدف فهم سبب ما يجري الآن في العالم العربي خاصة والعالم الإسلامي عامة إذ ليس من المعقول أن يجتمع الناس من كل بقاع الأرض لخراب بلد لا علاقة لهم به، وبعضهم لا يعرف أين يقع ولماذا هم فيه سوى أن رجالاً يدعون أنهم يمثلون الدين قد سمموا عقولهم بالكره لأهل الشام أو لشيعة العراق. فقد يكون في فهم سبب ما يحدث ما يمكننا من العمل لإيقافه أو تلافي تكراره، مما يمكننا من الخروج من الوضع المظلم الذي يجد العالم فيه المسلمين اليوم.
إذ لا يكفي أن يقف بعض رجال الدين المسلمين ليقولوا للعالم ان ما يجري ليس من الإسلام في شيء. فإذا لم يكن من الإسلام في شيء فمن أين جاء ولماذا كل الذين يقتلون ويخربون ويهدمون في أرض الشام والعراق وأفغانستان وليبيا وتونس ومصر هم من المسلمين، وكيف تجمعوا وما الذي جمعهم ومن جمعهم؟ إن أمراً كهذا لا يحدث عن طريق الصدفة. فإذا كان القول بأن الإرهاب ليس من أصل الإسلام فإن على رجال الدين المسلمين وقادة المذاهب اليوم أن يخرجوا بمشروع لوقف الإرهاب يبدأ من التعليم المشوه والكارثي في مساجدهم والذي يقدم للصهيونية العالمية خدمة مجانية عجزت أساطيلها وطائراتها عن تحقيقها. لكن الحقيقة هي أن رجال الدين لم يقدموا حتى اليوم سوى الكلام الفارغ والمجتر والذي أصبح يخدش الأسماع بأن الدين الحنيف ضد الإرهاب وضد القتل وضد… وضد…لكنهم مع ذلك يمجدون كل ما فعله خلفاء المسلمين في الألف عام المنصرمة. فهذا الإدعاء في رفض الإرهاب لا يتطابق مع ذلك الرضى والتمجيد بسياسات الخلفاء الأولين. إن على المسلمين أن يحسموا أمرهم فيتخلوا عن هذه الإزدواجية العارية. فإما هم ضد الإرهاب والقتل والتخريب باسم الدين في كل زمان ومكان مما يوجب عليهم إعادة تحليل تأريخ الإسلام في ضوء ذلك وإما هم مع الغزو والقتل والإغتصاب فعليهم يومها أن يسكتوا لأن ما يفعله السلفيون اليوم يتطابق بالكامل مع تلك النظرة. إن السلفيين، في أقل حال، أكثر صدقاً من عمائم المسلمين المنافقة التي تحاول أن تجمع بين الموقفين فتعجز.
فقد سبق وأن بينت أن الفرق في إسلام العرب وإسلام غيرهم من الدخلاء عليه هو ان العرب كانت لهم هوية قبل الإسلام وظلت تلك الهوية قائمة بعد الإسلام. أما غير العرب ممن أخذوا الإسلام فإنه، أي الإسلام، أصبح هوية لهم. فالباكستاني المسلم هو هندي لكنه رفض الهوية الهندية فليس له غير الإسلام هوية وكذا الحال مع الفارسي والتركي والشيشاني كل حسب هويته الأصلية التي أزاحتها الهوية الإسلامية.
فلم يجد العرب مشكلة في الولاء للدولة الأموية والعباسية فقد كانت هويتها عربية أولاً وإسلامية ثانياً ثم رضي بها حتى غير المسلمين من العرب. لكن الأمر تغير تماماً حين إدعى غير العرب حقهم في قيادة الإسلام، وقيادة العرب بالتبعية، فجاءت الدول المسخ من عثمانية وصفوية ومغولية لتشوه الإسلام بشتى الطقوس والقيم الموروثة من ثقافات الشعوب التي أنتجت تلك الدول. فضاعت العروبة وحيت تضيع العروبة يضيع الإسلام.
وقد أدرك أبو الطيب المتنبي ذلك من عهد مبكر في الإسلام فوصف الحال حتى قبل ولادة حكم الأتراك للعرب فقال (رحمه الله):
وإنما الناس بالملوك وما … تفلح عرب ملوكها عجم
لا أدب عندهم ولا حسب … ولا عهود لهم ولا ذمم
وهكذا غاب العرب عن المشهد الإنساني لقرون وكأنهم في سبات، وكان أطول من سبات أهل الكهف. فقد خدروا بقبول ولاية المسلم العثماني أو الفارسي أو المغولي بحجة أن له ولاية الخليفة الإسلامي الذي أختاره الله رغم أن الله لم يختر أي خليفة، ولم يساهم ذلك العربي المخدر في أية قضية تخص وجوده أو دينه.
وحين أتعب التأريخ بني عثمان بعد أن غرقوا في طلب الأرض والمال والجواري فقد كان على العرب أن يخرجوا من تلك الظلمة كما خرجت شعوب أخرى كانت معهم أسيرة القيد العثماني. لكنهم كانوا غير مهيئين في أغلب الأحوال للخروج ومواجهة الدنيا. فقد أمن العثمانيون في أكبر وأطول عملية تجهيل في التأريخ أن يبقى بين العرب أنفار فقط ممن تعلم أو حصل على شيء ينفعه في إدارة شؤونه…وقد خفف من ظلمة ذلك النفق الذي كان العرب فيه بشكل عام عاملان أولهما دخول نابليون إلى مصر وما جلبه معه من فرص علاقات مكنت مصر وأهلها من الإحتكاك بالنهضة الأوربية والثورة الصناعية قبل غيرهم من العرب. وثانيهما الوصاية الفرنسية على جزء من سورية الكبرى، والذي سمي لاحقاً بدولة لبنان. فقد أتاحت هذه الوصاية الباب أمام نصارى لبنان بشكل خاص للتعلم قبل غيرهم، ولم يغب عن أولئك النصارى إنتماؤهم العربي فأقبلوا على اللغة وعلومها والشعر والأدب فبحثوا فيها ونشروا وسبقوا أقرانهم من العرب المسلمين بعقود. وهكذا نجد أن الأدب العربي واللغة عادت للحياة في مصر ولبنان قبل غيرها من أرض العرب، وربما يمكن القول في هذه الحال: “رب ضارة نافعة”.
وحين طلع الجيل الجديد بين الحربين العالميتين في القرن العشرين فإنه كان جيلاً متعطشاً للمعرفة والتعليم بعد طول ظمأ عاشه سلفه، فكان الاحتكاك بالغرب الذي خلق نهضة فكرية كبيرة أدت لولادة حركة ثورة في المشرق العربي بشكل خاص (وهو إصطلاح مجازي إذ أنه يضم مصر) فإنحاز الشباب العرب الناشئون والمتطلعون لتغيير جذري إما للمشروع الشيوعي في تقبل الفكر الماركسي وبناء دولة على غرار ما فعله لينين في روسيا أو للمشروع القومي الذي ولد في أفكار بعض العرب الذين تاثروا بمشروع الدولة الوطنية التي قامت أوربا عليها في القرن الماضي. وقد كان طبيعياً أن يكون لغير المسلمين قصب السبق في هذين الإتجاهين!
وحيث إن طبيعة الثورة، أية ثورة، هي أنها طريق النخبة فإن تأثير هؤلاء الشباب من الثوار العرب، شيوعيين كانوا أم قوميين، ظل محصوراً في الدائرة الصغيرة. أما الأغلبية، والتي لا تحب بطبعها التغيير الجذري، فقد وجدت في البقاء على ما تعلمته من مبادئ الإسلام أسلم طريق للديمومة. وهذا جعل من السهل على من مازال يحلم بقيام دولة إسلامية، تجدد عهد الخلافة الغابر وتعيد للعرب مجد العباسيين، أن يجد تعاطفاً كبيراً ولو حتى باللسان بين أغلب الجمهور العربي المسلم. فنشأت حركات إسلامية خجولة أول الأمر لكنها سرعان ما نظمت نفسها فأنتجت أول حركة سياسية منظمة في إخوان مصر ثم تبعها إخوان سورية فإخوان العراق. وكان قد سبق حركات الإخوان نشوء الحركة السلفية الأم في المشروع الصهيوني الوهابي كما سبق وأوضحت. فسارعت الصهيونية إلى دعم حركة الإخوان حين أدركت أنه لا طائل من محاولة فرض السلفية أو الوهابية على المشرق العربي إذ ان الظرف لم يكن قد نضج بعد لقبولها فوجب والحال كذلك دعم البديل الإسلامي المتمثل في حركة الإخوان. وهكذا فإن حركة الإخوان المسلمين في مصر لم يكن لديها مشكلة مع نظام فاروق الفاسد والأجير لإستكبار الصهيونية العالمية لكنها لم تكتف بمعارضة نظام جمال عبد الناصر التقدمي القومي حسب بل حملت السلاح ضده. وهذا لا يمكن أن يفسر إلا لأن الصهيونية لم تكن راضية عن عبد الناصر وان الإخوان كانوا في ركاب الصهيونية في ذلك الوقت واليوم وربما غداً.
وسبب إنحياز الحركات الإسلامية للصهيونية هو أن القاعدة التي نشأت عليها هذه الحركات هي بناء دولة إسلامية ولا يقتضي لهذه الدولة أن تتطلع للحرية أو الإستقلال السياسي أو بناء نظام إقتصادي فيه عدالة إجتماعية. إذ يكفي المشروع السياسي لحركة الإخوان عامة هو قيام دولة إسلامية تطبق فيها فروض الإسلام وقواعد الشريعة الإسلامية. فإذا كان تحقيق هذا يتطلب التعاون مع الصهيونية فليكن الأمر كذلك، فما هو التعارض؟ وسرعان ما اكتشفت الصهيونية العالمية أن هذا هو عين ما تريده فما شأنها إذا فرض المسلمون على سكانهم الصلاة والصوم بالعصى وأخذو الزكاة بالجلد، وما شأنهم إذا قطع المسلمون أيدي اللصوص في بلدانهم وما شأن الصهيوينة العالمية إذا قرر المسلمون رجم الزناة في بلدانهم؟ وهذا الأمر لم يكن كذلك مع المشروع القومي أو الشيوعي في العالم العربي والذي كان له مواقف سياسية مناهضة للمشروع الصهيوني العالمي في الهيمنة.
وظلت الصهيونية العالمية على وفاق تام مع الحركة السياسية الإسلامية لعقود. ففي الوطن العربي شمال جزيرة العرب وجدت في حركة الإخوان المسلمين خير حليف وفي جزيرة العرب وجدت في ربيبتها الوهابية خادماً مطيعاً وسبباً لتخدير ملايين المسلمين خارج أرض العرب.
أما المؤسسة الدينية الرسمية فهي الآن كما كانت منذ قرون أسيرة سلطان الخليفة أو الحاكم. فقد كان مفتي إستانبول ذراع السلطان العثماني يسوق له سياساته ويفتي بتحليل الحرام وتحريم الحلال كما يشتهي الخليفة. وهكذا أصبح الدين ومؤسساته مطية الحاكم وليس المحاسب والرقيب عليها. واستمر الحال هذا في الدول الإسلامية التي ولدت بعد إنهيار الدولة العثمانية أو التي كانت خارجها على حد سواء. فاطمأن حكام العالم العربي الفاسدون والمفسدون في الإعتماد على فتاوى خدمهم من رجال الدين الذين دأبوا على مدح الحاكم والدعاء للعلي القدير أن يحفظه وملكه. إن عدم استقلال المؤسسة الدينية الإسلامية عن الحاكم لعب دوراً اساساً في فساد السياسة الدينية لقرون، تماماً كما سبق وفعلت الكنيسة النصرانية في أوربا قبل عصر التنوير.
ولم يكن حال المؤسسة الدينية الشيعية أفضل من أختها السنية رغم أن الأولى تمثل أقل من عشرين بالمائة من مسلمي العالم. بل ربما كانت المؤسسة الشيعية أكثر عرضة لهيمنة الصهيونية عليها في بعض الأحيان. ذلك لأن رجال الدين الشيعة، شانهم في ذلك شأن رجال الدين السنة، همهم المحافظة على الدين الإسلامي على وفق مذهبهم لقناعتهم أنهم يمثلون صدق الدين. فقد وجد هؤلاء أنهم وسط محيط سني كبير ومعاد بغريزته التي اشبعتها كتب الإسلام لقرون ويكفي أن يقرأ أي شخص فتاوى إبن تيمية ليعرف معنى ما أقول. فاعتقدوا أن عليهم من أجل المحافظة على الطائفة الصغيرة أن يتفقوا مع أي من يمكن أن يدافع عنهم. فكان ولاء المرجعية الدينية الشيعية بشكل عام للغرب الصهيوني. وهذه كانت الحقيقة طيلة القرن الماضي بشكل عام ولم يغير منها ظهور حركة ولاية الفقيه التي وقفت وقفاً معارضاً لذلك التوجه فهي، أي ولاية الفقيه، ما زالت حتى اليوم وبعد ثلاثين عاماً على نجاحها في تأسيس الجمهورية الإسلامية ليست مقبولة داخل المرجعية الدينية الشيعية ونسمع بين الحين والآخر تعليقاً سلبياً من طرف على الآخر.
وقد إتضح المفهوم السياسي الإسلامي بشكل عام من موقف كل من طهران وحزب الله من حركة حماس. فقد كانت حركة حماس تتخذ من دمشق مقراً آمناً لها بحماية بعث سورية ودعمه. وتم تسمية الطيف الذي ضم إيران وسورية وحزب الله وحماس وحركة الجهاد محور المقاومة أو الممانعة… وهكذا كان حتى تفجر الوضع في سورية. وحيث إن هذا المقال ليس بصدد تحليل ما حدث في سورية فسوف أكتفي بإستخلاص حقيقة واخدة منه ألا وهي أن حركة حماس وجدت نفسها تقف، بحكم إنتمائها لحركة الإخوان المسلمين العالمية، مع التمرد المسلح ضد نظام البعث. فوقف أمينها العام البائس على منصة المعارضة السورية ورفع علم الإنتداب الفرنسي. ثم نقلت الحركة قيادتها إلى قطر قاعدة الصهيونية العالمية الكبري في الخليج وجزيرة العرب حيث يسرح ويمرح ضباط المخابرات الصهيونية. ولا أقول ما قاله العديد من المعلقين أن حماس أنكرت الجميل فلست معنياً بذلك لكني معني بأن حماس وجدت أن الإنتماء لحركة الإخوان والتي تطمع في بناء دولة إسلامية له أسبقية على الموقف الوجودي في الصراع ضد الصهيونية، فكشفت حقيقة أنها لا تحارب الصهيونية لأن الأخيرة تشكل خطراً على الوجود العربي لكنها كانت تحاربها فقط لأنها منعتها من إقامة دولة إسلامية. فلو أن الصهيونية تدعم قيام دولة إسلامية في فلسطين لسارعت حماس للدخول في صفقة معها.
وقد وجدت طهران نفسها في موقف عصيب، وعانى حزب الله من الحرج نفسه وإن كان بدرجة أقل. ذلك لأن كليهما كان وما زال يؤمن بصدقية معركة حماس ضد الصهيوينة وقد يجد لها الأعذار في وقوفها مع حركة الإخوان المسلمين بسبب أن نظام البعث اضطهد الحركة الدينية بشكل عام. وقد برز هذا الموقف بشكل واضح في دعم طهران لحكم الإخوان المسلمين في مصر كذلك. وهكذا فقد وجدت الحركة الشيعية السياسية الفاعلة في طهران ولبنان نفسها أمام خيار صعب. فهي من جانب لا يمكن أن تفرط بنظام البعث الذي تؤمن أنه معها في المعركة المناهضة للهيمنة الصهيونية ومن جانب آخر لا يمكن لها أن تدير ظهرها لحركة إسلامية دينية تقاتل الصهيونية لإن هناك قناعة مبدئية لديها أن كل حركة إسلامية سياسية مناهضة للصهيونية يجب أن تدعم بحكم الأخوة الدينية حتى إذا شطت تلك الحركة وخرجت عن الخط كما حدث لحماس. ففترت العلاقة بين حزب الله وحماس بشكل كبير وبشكل أقل فتوراً بين حماس وطهران لأسباب ليس هذا مجال الخوض فيها وتتعلق بطبيعة القيادة السياسية في طهران والتي ليست بانسجام القيادة السياسية داخل حزب الله. بل إن هناك روايات تتحدث عن إكتشاف حزب الله أثناء قتاله في سورية بأن بعض الأسلحة التي بيد المعارضة السورية المسلحة كانت من السلاح الذي مدت به حماس.
فخيار إيران أقل صعوبة لأنها تؤمن بدولة إسلامية عالمية تقودها هي بنظرية ولاية الفقيه وهي بهذا ليس لديها مانع من التعاون مع أية حركة إسلامية تشاركها هذا الحلم حتى إذا كانت تلك الحركة لا تؤمن بولاية الفقيه كما هو حال حماس. أما خيار حزب الله فكان وما زال أصعب. ذلك لأن حزب الله حزب عروبي وجد في ولاية الفقيه الطريق الوحيد للفكر الشيعي في أن يواجه الصهيونية، فهو يجد أن موقفه ينسجم مع طهران لأن الأخيرة تهتدي بولاية الفقيه، كما ان موقفه بنسجم مع سورية لأن الأخيرة تقاتل دفاعاً عن الوجود القومي العربي الذي يشكل حزب الله جزءً منه والذي تهدده الصهيونية ليس بسبب إسلامه ولكن بسبب وجوده!
إلا أن الحرب الأهلية في سورية كشفت حقيقة أخطر في الإسلام السياسي وما ينتظر المسلمين. فقد وضحت الطبيعة المذهبية للإسلام السياسي فتبين أنه لا يوجد إسلام واحد يمكن أن تقوم على أساسه دولة إسلامية. فإيران الشيعية أصبحت في نظر السلفية السنية تشكل قاعدة الهلال الشيعي الذي يهدد وجود المسلمين السنة وسلاح حزب الله يهدد سنة لبنان وليس الدولة الصهيونية … وتجاوز هذا التقسيم بين دولة سنية وشيعية إلى أن الدولة السنية نفسها موضع تنازع فهي عند الإخوان غيرها عند السلفية وكل طرف يدعي أنه وحده مصيب وغيره مخطئ أو كافر، مما يعني قتاله…. إن هذا التموضع الجديد للإسلام السياسي خلق حالة من التشرذم في العالم العربي والإسلامي لم تتمكن كل حروب الصهيونية من تحقيقها. فقد حول الإسلام السياسي الوطن العربي إلى طوائف وقبائل تتقاتل حتى دون أن تعرف لماذا!
فهل يمكن إيقاف هذا؟ ما هو الطريق وهل ينفع؟ هذا ما ساحاول أن أختم بهذه هذه السلسلة إن شاء الله.
وللحديث صلة…
عبد الحق العاني