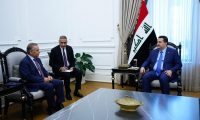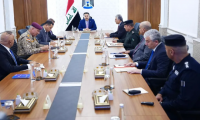عواد علي
غيرت الثورات والتحولات الاجتماعية، وتطور الحركات الطليعية في الغرب خلال مطلع القرن العشرين، بشكل أساسي، نظام القيم الأخلاقية والجمالية التي كانت سائدة في المسرح، فلم تعد ثمة أي قيم تتمتع بشرعية مطلقة في المجتمع الغربي، وانحسرت الأعراف المسرحية التي يقبل بها المسرح بشكل عام، وحل مكانها تنوع بارز في المعايير الأخلاقية والجمالية أكثر من أي وقت مضى. ولذلك صار أي نوع من الإخراج لمسرحية ما أمراً ممكناً، كما تقول الباحثة الألمانية إريكا فيشر ليشته.
وكان لظهور النظريات اللغوية والسيميائية أثر كبير في خلق هذا التنوع، بل الاختلاف بين نظام النص المسرحي ونظام العرض، فقد أصبح واضحاً أن النص المكتوب يتألف من علامات لفظية (حروف فقط) بوصفه خطاباً لغوياً، في حين أن العرض يتألف من علامات لفظية وغير لفظية كعلامات ما وراء اللغة أو اللغة الشارحة، وتلك التي تصدر عن الجسد وعلاقتها بالكلام (الحركات والإيماءات)، والأزياء، والسينوغرافيا، والرقص، والمكياج. هكذا غدت العلاقة بين النص والعرض، عملية سيرورة يتشكل النص عبرها بوساطة نظام سيميائي معين، ثم يتحول إلى نص لنظام سيميائي آخر في الإخراج، أو العرض.
لكن ما دام التطابق غير قائم بين العلامات اللفظية للنص وعلامات العرض، فإن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يقوم المخرج بعملية تحويل النص إلى عرض مشهدي؟ يتعين التوكيد أن نقطة الانطلاق لا تكمن في النص فعلياً، بل في قراءته، فليس مطلوباً من المخرج أن ينطلق من النص كما هو، بل كما يقرؤه ويدركه.
إن مفهوم القراءة هنا يشبه مفهوم القراءة في النقد الحديث، فهو فعالية تملأ الفجوات، أو النقاط اللامحددة، العائمة، الحرة في النص المسرحي، وتضيف قدراً من التحديد، لا التقييد، إلى الموضوعات التي يتضمنها في خطوط عامة. لهذا فإن الخطوة الأولى لأي تحول ستتوقف على قراءة النص، تلك الفعالية التي يُعطى من خلالها معنى لعناصره الفنية، وللتراكيب التعبيرية المتتابعة (السلسلة المتجاورة من الألفاظ التي يكوّنها التعاقب الخطي أو الأفقي للّغة) الأكثر تعقيداً، وللنص ككل.
وفقاً لذلك، تكمن نقطة الانطلاق في المعاني التي تطورت أثناء عملية القراءة، ومهمة المخرج والممثلين هي البحث عن علامات مسرحية قادرة على التعبير عن تلك المعاني ونقلها، كما جرى تأكيد أن اختيار علامات مسرحية ممكنة لا يمكن حصره بالنص المكتوب، ولا يمكن أن تجمع من ذلك النص سوى معانٍ، ولأجل تلك المعاني ينبغي أن نجد العلامات المسرحية الملائمة، ولكن لن تكون العلامات ذاتها.
يمكن إيراد مثال على ذلك بأنه حتى لو كانت الإرشادات، أو التوجيهات المسرحية التي يضعها المؤلف، تبين بأن الشخصية المسرحية تتنهد، أو تركض، أو تجلس كي تعبّر عن انفعال معين، فليس من الضروري اتباع هذه الإرشادات، التي ربما كانت قد تقررت وفق أعراف مسرحية للزمن الذي كُتب فيه النص. ثمة أمثلة كثيرة على تغيير المخرج لتوجيهات المؤلف الخاصة بسلوك الشخصيات، أو انفعالها في النص المسرحي كما في تجارب العديد من المخرجين العرب، ناهيك عن عدم تقيّد أغلبهم بمواصفات الفضاءات المقترحة في النص، وأزياء الشخصيات، وعناصر أخرى سمعية وبصرية. هذا يثبت أن عملية التحول لا يمكن أن تقودها الأسس التي تقوم عليها بنية المسرحية المكتوبة، بل قراءة المخرج ورؤيته الجمالية والفلسفية.
من بين أشكال التحول الأساسية: «التحول التتابعي»، «التحول البنيوي»، و»التحول الكلي»، ويُعد الأخير أكثرها شمولاً، إلى درجة أنه يتضمن الشكلين الآخرين بوصفهما قابلين للتحقيق، فهو يُستمد من النص ككل، بناءً ودلالةً. ولكي يجري التعبير عن هذا الشكل من التحول من خلال العلامات المسرحية يكون من المفيد، حسب رأي ليشته، تحويل جملة بعد جملة، أو تركيب النصوص التحتية كمعانٍ مركبة للبنى الفرعية.
من ناحية أخرى، قد يرى المخرج أن معنى المسرحية ينتقل، بشكل أفضل، عبر الإخراج الذي ينقل أجزاءً من الحوار، أو يبدّل بعض البنى الفرعية، أو حتى إنه قد يحذف بعضها، ويستبدل غيرها بها. في هذه الحال يكون البناء الدلالي للمسرحية قد أنتج ثانيةً من خلال الإخراج. هكذا يعمل العرض، الذي جرى إخراجه ككل، بمثابة معنى للنص بمجمله.
لقد تميز الإخراج المسرحي الخلاّق للقرن العشرين بمنهجه الكلي الذي يعبّر عن اجتهادات لا حدود لها، ومغامرات فنية، واتجاهات مختلفة يجمع بينها المنحى التجريبي والطليعي، ويتصدر فيه اشتغال المخرج على البناء المشهدي، والبحث عن فضاءات جديدة، والقراءة المغايرة المنتجة التي تهدف إلى الإمساك بما هو مسكوت عنه في النص، أو لا مفَكّر فيه، وإطلاقه في فضاء العرض في صيغة علامات حرة لا تكتمل دلالاتها إلاّ بفعل قراءة المتلقي لها، وفعاليته في استنطاقها وتأويلها. وبذلك تداخلت رؤية المخرج (القارئ الأول للنص)، ورؤية المتلقي (القارئ الثاني للنص والعرض) في إنتاج الخطاب المسرحي، وإثراء رؤية المؤلف.
الإخراج المسرحي والقراءة المشهدية للنص

آخر تحديث: